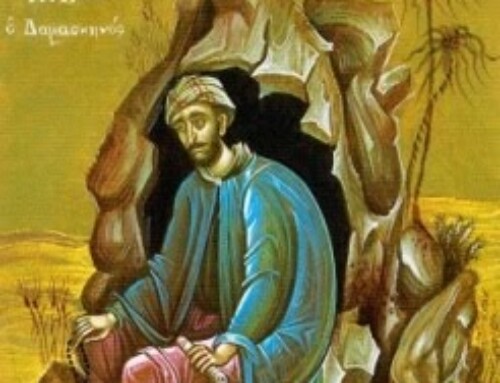عظة للمطران بولس يازجيالأحد السابع من متى: (متى 9 : 27 – 35)“فتعجّب الجموع قائلين، لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل،أما الفريسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين”ترافقت العجائب مع تعليم يسوع، الذي ظهر أنّه يعلّم كمن له سلطان. وكانت هذه العجائب أداةً لإثبات صحّة تعليم يسوع وللكشف عن شخصه بالنبي المنتظر “المسيح”، الذي سيشفي المرضى وسيجعل العميان يبصرون…والنصّ الإنجيليّ اليوم يمكننا تسميته “نصّ العجائب”، لأنه يتكلّم بالوقت ذاته عن شفاء أعميَين، ثم أخرس به شيطان. وأمام هذه الأحداث انقسم الناس في تفسيرها. فالبعض رأى فيها مدلولاً على ألوهيّة يسوع، وقال “لم نرَ مثل هذا”. أما الآخرون فاعتبروامصدرها شيطانيّاً وقالوا “برئيس الشياطين يُخرج الشياطين”.لم تنحصر العجائب في زمن يسوع، بل التلاميذ أنفسهم بعده كانوا يؤيّدون البشارة بالقوى والعجائب. ويؤكّد فصلُ أعمال الرسل بعجائبه العديدة ما قاله يسوع، أن من يؤمن به يعمل الأعمال التي هو عملها لا بل ما هو أعظم منها أيضاً. وفي أيّامنا، كما قديماً، ينقسم الناس أمام مظاهر كهذه. فالبعض يعتبرونها فكرة ومظاهر قديمة. بينما آخرون يبدون في طريقة إيمانهم شغفاً بها لدرجة الاعتقاد بالخوارق الكاذبة. فالانقسام الذي رأيناه في النصّ الإنجيليّ يحدث اليوم أمام بعض العجائب. حيث يرى البعض في كلّ عجيبة مصدراً إلهيّاً. بينما آخرون يرونها مظاهر شيطانيّة.العجيبة بالأصل، ليست ظاهرة خارقة للطبيعة وحسب! إنّما أداة لتثبيت البشارة، و”علامة” تشير إلى الحضور الإلهيّ وحبّه وحنانه وعنايته بالإنسان.الأعجوبة هي صرخة أن “الله هنا” والآن. لأنه حيث تُغلب الطبيعة فهناك سيّد الطبيعة. والعجيبة كحدث يفوق الأمور الطبيعيّة يمكن أن يكون لها مصادر ثلاثة. الأوّل هو الله، والثاني هو العلم، والثالث هو الشيطان.فالعلم يصل في حالات إلى درجة المعجزات حين يعجز إدراك الناس عن فهمه أو توقّعه. ليست قليلة الحالات التي يمكننا باستخدام منجزات واختراعات علميّة حديثة أن نصل إلى ما يعتبره كثيرون “خوارق طبيعيّة”. فإنّ تفاوت القدرات والمعرفة العلميّة تسمح مرّات عديدة لطرف ما بتجاوز مفاهيم وإدراك الطرف الآخر بشكل إعجابي وبتحقيق ما يمكن تصوّره بـ “معجزة”.إنّ هذه الخوارق العلميّة، مرتبطة بالمعرفة والزمن. وأسرار العلم والاختراعات عديدة. إلاّ أنّها أقرب إلى السحر منها إلى “الآية” التي تذكر أنّ “الله هنا”. ولا علاقة لهذه الخوارق و”العجائب” العلمية بعجائب الكتاب المقدس وغايتها. أما المصدر الآخر للعجائب فهو الشيطان. واليهود أنفسهم نسبوا أعمال يسوع إليه. وهذا واقع تعرفه الكنيسة، أنّ هناك عجائب، أي أحداث، فوق طبيعيّة، مصدرها الشيطان، الذي كما يقول سفر الرؤيا سوف يُضِلُّ قلوب كثيرين. وما السحر إلا مظهر لتعاون الإنسان مع الشيطان لتحقيق المعجزات، التي تطيب وتحلو للناس، وخاصّة في عالمنا الشرقيّ بحماسه الدينيّ، عند السطحيَّين منهم. فتحضير الأرواح، والتبصير وقراءة الفنجان، والحُجب والكتب… كلّها بمثابة “معجزات” ولكن مصدرها هو الشيطان. هذه لا تقول “الله هنا” ولكنّها تُضّل الكثيرين. العجائب الصالحة هي التي مصدرها الله.
ولكن كيف نميّز مصدر كلّ أعجوبة. إنّ مظاهر الأعاجيب هي واحدة، بمعنى أنّها تفوق الطبيعيّ وتسمو على إدراكنا العقلانيّ. لذلك لا يقوم تمييزها على أساس استخدام العقل وحده هنا، حيث هو أمام كلّ معجزة عاجز.
الكنيسة بالأساس تريد أن يجلب الإيمانُ العجيبةَ وليس أن تجلب العجيبةُ الإيمان. والعجائب هي وسائل لبشارة الضعفاء أو قساة القلوب، الكلمة هي الأفضل. والكنيسة ترفض كلّ عجيبة حتّى يثبّتها الله بعد زمن. نحن حذرون من العجائب ولسنا شغفين بها. اليوم بعد انتشار البشارة باتت ضرورة العجائب في المسيحيّة نادرة. فكيف نميّز إذن “مصدر العجيبة”، وكيف نحكم عليها حين تحصل؟ وأين نصنّفها عندما نتعرّض لها؟ أَهي ألعوبة علميّة، أم سحر شيطانيّ، أم عناية إلهيّة؟ لا يوجد أي ضوء يكشف مصدر الأعاجيب إلا “معرفة الله”، أي معرفتنا له. وبالتالي بالوقت ذاته معرفتنا بألاعيب الشيطان.
أصدقاء الله هم المقياس الوحيد لتحديد مصدر كلّ عجيبة. وهذا ما نختبره نحن أيضاً على مستوى العلاقات الإنسانيّة العاديّة. إذا أخبرونا مثلاً أن فلاناً قام بعمل جبّار لفلان، لا يمكن أن نحكم على صدق ذلك إلا بناء على معرفتنا الشخصيّة به. فإذا أخبرونا أنّ والد فلان من الناس قد أجرى عجيبة حين شرح له مسألة صعبة للامتحان. فمعرفتنا بهذا الوالد الشخصيّة يمكن أن تقودنا إلى رفضها واعتبار أنّ هذا الوالد لا يربّي أولاده هكذا بل ينميهم بالمعرفة؛ أو عكس ذلك. أي خبر عن إنسان ما قد يكون موضع تصديق أو شك عند الناس. ولكن الشخص الوحيد القادر أن يحكم بشكل قاطع في هذا الخبر صديقُه، لأنّه يعرف تماماً ما يمكن لهذا الصديق أن يتصرّف أو يعمل.
من يعرف الله حقاً يشعر به، نعم ويشعر معه! يعرف ما يمكن لله أن يريده وأن يعمله. إنّه حسّ يتولّد من معرفة – تعارف صداقة بين الإنسان والله. بالطبع هناك مدلولات عقلانيّة وإيمانيّة عامّة، لكنّها لوحدها قاصرة وقد تخطئ. ومنها أن تحمل العجيبة علامات المحبّة والخير والبشارة… لكن الأمثلة في الكتاب المقدس عديدة حين كان الشيطان يستخدم أعاجيب لها هذه المظاهر في البداية، لكي يقودنا إلى تصديقها ثم يذهب بنا إلى مقاصده الشريرة بعدها. فالشيطان يخلط الأمور لكي يصطاد السذّج من الناس ويفترس الخروف المنفرد عن القطيع.
اللجوء إلى أصدقاء الله، إلى القدّيسين والمرشدين هو الطريق الأسلم والصحيح لقراءة كلّ عجيبة وفهم غايتها.
الفريسيّون لم ينكروا على المسيح حقيقة الأحداث العجائبيّة لكنّهم أخطأوا بفهم مصدرها. فرأوا فيها ظواهر تدخّل شيطانـيّ بدل أن تحثّهم إلى الإيمان بيسوع وإلى معرفته وأن تكون لهم “علامة” عنايته وحبّه، وذلك لأنهم كانوا يحكمون بروح الامتعاض والكراهيّة تجاه يسوع وليس بروح الله. روح الله يسكن في القدّيسين الذي يعرفون تماماً تحرّكات سيّدهم وربّهم وربّنا. آمين
المطران بولس يازجي