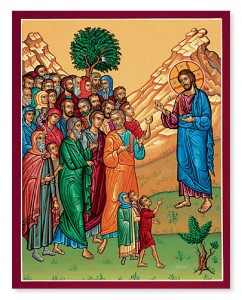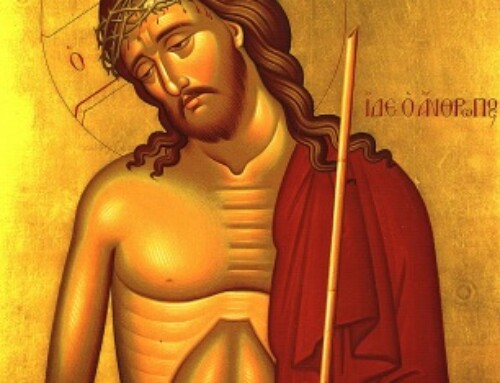شرح وتفسير صلاة الابانا
تعتبر ‘الصلاة الربّيّة’ (أبانا الذي في السماوات ليتقدّس اسمُك…)، كما أسماها، لأوّل مرّة، القدّيس كبريانوس القرطاجيّ (+258)، من أكثر الصلوات التي يتلوها مسيحيّو العالم شهرةً، وذلك أنّها ‘الصلاة’ التي علّمها يسوع للكنيسة،
وأرادها نموذجًا لكلّ صلاة . منذ البدء أبدى آباء الكنيسة اهتمامًا بالغًا بهذه الصلاة، فتركوا تفسيرات كثيرة عنها، وعملوا على إدراجها في الأسرار المقدّسة والصلوات الكنسيّة، وهي موجودة اليوم في جميع صلواتنا الجماعيّة والفرديّة .
القدّيس كبريانوس الذي كان يطلب من الموعوظين (وهم وثنيّون ويهود آمنوا بالربّ يسوع وكانوا يستعدّون لتقبّل سرّ المعموديّة) حفظها غيبًا وتلاوتها علنًا أمام الكنيسة أثناء قبولهم المعموديّة. حذا حذومعظمُ آباء القرن الرابع فأدرجوا هذه الصلاة في خدمة القدّاس الإلهيّ . ففي كنيسة أورشليم، مثلاً، كان القدّيس كيرلّس يشرحها أثناء الخدمة الإلهيّة، ويطلب من المؤمنين تلاوتَها قبل أن يتقدّموا من المناولة، وهذا ما يفعله المؤمنون اليوم .
لعلّ أبرز ما يميّزها عن كلّ الصلوات التي قبلها هو تلك الحرّيّة التي تدفع المؤمنين إلى أن ينادوا الله الذي لا يدنى منه: ‘أبانا‘.
لصلاة الربّيّة – على الرغم من صغرها – صلاة غنيّة بمعانيها، وقد وصلتنا عن يد الإنجيليّين متّى (6: 9-13) ولوقا (11: 2-4)، في صيغتين تفترق الواحدة عن الأخرى، بأمور عدّة،
لقد وصلنا نص الصلاة الربية في صيغتين: الاولى مقتضبة في لوقا 11: 2-4 والثانية مطولة في متى 6: 9-13 وهذا لايعني ان احداً اختصر منها، بينما من المحتمل ان يضاف اليه خاصة للاستعمال الطقسي.
يبدأ لوقا بكلمة” ايها الاب” المقابلة لكلمة” أبا” كما لايذكر لوقا عبارة ” الذي في السموات” التي نراها عند متى، ماذا يعني ذلك؟
يخبرنا لوقا ان احد التلاميذ طلب من يسوع قائلاً:” يارب علمنا ان نصلي ” اي ان التلاميذ تمنوا ان تكون لهم صلاة خاصة بهم كما كان لتلاميذ المعمدان او الفريسيين او اللاسينيين. ولبى يسوع طلبهم وسمح لهم ان يدعوا الله أبا كما كان يفعل ودعاهم لاتصال بالشركة الروحية التي كان له مع الله.
النصوص
لوقا 11 : 2- 4 ” ايها الاب ليتقدس اسمك ليأتِ ملكوتك خبزنا كفافنا اعطنا كل يوم واغفر لنا خطايانا لاننا نحن ايضاً نغفر لكل من اساء الينا ولاتدخلنا في تجربة “
متى 6 : 9-13 “ابانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتِ ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لمن اساء الينا ولاتدخلنا في تجربة بل نجنا من الشرير”
الديداخي 8 : 2- 4″ ابانا الذي في السماء ليتقدس اسمك ليأتِ ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اعطنا اليوم خبزنا كفافنا واترك لنا ما علينا كما نترك لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة بل نجنا من الشرير لان لك القدرة والمجد الى الاجيال
الصلاة الربية في التقليدين الانجيليين علاقتهما المتبادلة – ظروف اصلهما
وصلت الصلاة الربية في العهد الجديد بصيغتين مختلفتين : متى 6: 9-13 ولوقا 11 :2-4 ويوجد الى جانبهما نص قديم ورد في تقليد موغل في القدم هو كتاب الديداخي اي ” تعليم الاثني عشر” (8: 2-4 ) ويرجع الى القرن الثاني بل لعله كتب في نهاية المئة الاولى المسيحية .
أ- العلاقة المتبادلة بين النصين
علينا ان لا ننظر الى النصين وكأن متى فضل ان يطيله ، وفضل لوقا اختصاره. بل علينا ان نرجع الى المصدر حيث تلقى كلاهما صلاة الجماعة المسيحية الاولى التي كان كل منهما على علاقة بها .
الاطالة في نص متى نراها في التقليد الليتورجي وفي الكرازة, وبأمكاننا ان نضيف بعض الخاصيات الملازمة لتفكير متى اللاهوتي : فمثلاً جملة “الاب الذي في السموات” نلقاها عشرين مرة في انجيل متى. فالكلام عن الله بهذه الصورة هو من التعابير الخاصة بالجماعة اليهودية المتنصرة ومتى واحد منهم. كذلك التعابير الخاصة بأرادة الله ومشيئته هي من صميم الفكر اليهودي ولما كان متى قد كتب انجيله في بيئة يهودية فانه يكثر من ذكر التعابير المقبولة في محيطه ( متى7: 21، متى5: 18-19).
اما الجماعة التي ينتمي اليها لوقا فقد ادخلت هذه الصلاة في طريقة تفكيرها. ففي انجيله يرد القول عن الخبز (لكل يوم) وليس ( لهذا اليوم ) فحسب, هذا التعبير يلازم فكرة الجماعة التي لم تعد تنتظر فكرة عودة المسيح القريبة. لقد وضعوا نصب اعينهم مزيداً من الايام القادمة.
ولفظة ” الذنوب” بمعنى الديون تغيرت الى ” خطايا ” وهذا ابتعاد ايضاً عن الفكرة اليهودية التي تقول ان المؤمنين مديونون لله. بينما اختلفت عند المتنصرين ولكي يكون النص اكثر قبولاً فضل لوقا استعمال كلمة ” خطايا ” .
مما زاد في انتشار نص متى بسرعة وادخاله في الاستعمال الليتورجي هو لما فيه من اجلال وكذلك الاعتقاد السائد بان انجيل متى هو اقدم الاناجيل.
ان النص القديم الذي حفظه لنا كتاب ” تعليم الاثني عشر” يتبع عن قرب نص متى وفيه ينعكس التفكير اليهودي – النصراني في واجب حفظ الشريعة. لكنه يختلف عن نص متى باستعماله لفظتين في حالة المفرد : ” السماء” و ” ذنبنا ” والاختلاف الاهم هو في المجدلة التي الحقت بالصلاة الربية في المخطوطات المتأخرة للانجيل.
ب- ظروف الاصل
لايخبرنا متى عن الظروف التي احاطت بانبثاق الصلاة الربية فقد وضعها ضمن موعظة الجبل عن الصلاة والصوم. وكذلك كتاب ” تعليم الاثني عشر” ادخلها ضمن الحديث عن الصلاة والصوم . وليس في النصين اي تنويه بالجو التاريخي المهيمن على حياة يسوع حين املى هذه الصلاة. بل بالاحرى يشيران الى محيط الكنيسة البدائية وطريقة تفكيرها وصلاتها . وهذه امور نتوقف عندها قبل دراسة المعطيات الخاصة بلوقا.
· ” ومتى صليتم فلا تكونوا كالمرائين، فأنهم يحبون الصلاة قياما في المجامع، وفي زوايا الساحات، لكي يظهروا للناس ” ( متى 6: 5)
” اما انت ، فمتى صليت فادخل مخدعك واوصد بابك، وصلِ الى ابيك الذي في الخفية” ( متى6: 6)
الصلاة هي التوجه نحو الله ومن يصلي بحجة اعطاء المثل الصالح للآخرين فعمل من الرياء, والاستعراض امام الاخرين ليمدحوا تقوانا فذلك حب الظهور متجلبب بلباس الدين. فالمستحسن الانزواء وعدم التفكير بامور الدنيا ومحاولة الاتصال بالله على مثال المسيح.
· ” وفي صلواتكم لا تكرروا الكلام عبثاً مثل الوثنيين، فانهم يتوهمون انهم لكثرة الكلام يستجاب لهم, فلا تتشبهوا بهم، فان اباكم يعلم بما تحتاجون اليه قبل ان تسالوه” ( متى 6: 7- 8 ) .
ان المسيح لا ينكر علينا عرض حاجاتنا اما الله. فهو القائل: ” اسالوا تعطوا، اطلبوا تجدوا ، دقوا الباب يفتح لكم” ( متى 7: 7 ) ويؤكد ذلك المثل الذي رواه ( لوقا 11: 5- 8 ) عن الصديق الذي ياتي ليلاً طالباً الخبز ولايتزعزع الا بعد نيله مبتغاه. المهم اذا هو تغيير العقلية اي رفع الصلاة بثقة الى الله.
كذلك لا يدين المسيح الصلاة الطويلة فهو نفسه كان يقضي ليالٍ باكملها في الصلاة ( لوقا 6: 12). ولكن يجب ان لاتكون الصلاة بدافع التأثير على الله ، بل كتعبير عن حاجاتنا للتقرب الى الله. فإن سبّب طول الصلاة ملللاً في النفس فلتهمل لانها فقدت غايتها ولم تعد واسطة للتقرب الى الله .
اعتاد البعض على تقسيم الصلاة الربّيّة إلى قسمين؛ أمور السماء (وهي الطلبات الثلاث الأولى)و أمور الأرض وحاجاتها’ من هنا – يجب أن نفهمه بتوافقه ومجمل فكر يسوع الذي يدعو إلى عيش الآخرة أوّلاً والعمل على تبيانها ‘الآن وهنا’ (يقول الربّ: ‘اطلبوا أوّلاً ملكوت الله وبّره…’) .
وذلك انّ الذي يُرضي الله ليس أن نقدّس اسمه بإخلاصنا له فقط، ولكن بعملنا على خلاص البشر أيضًا (فلا يجوز أن نفهم، مثلاً، أنّ الطلبة الثانية في الصلاة الربّيّة: ‘ليأتِ ملكوتُك’، تختصّ فقط برغبة المؤمنين في حلول الملكوت الآتي، لأنّ أولاد الله الحقيقيّين لا يعترفون بمجد الله الأخير فحسب، أو يتـوقون فقـط إلى اليـوم الـذي يملك فيه على كلّ أحبائه ‘ويُخضع كلّ أعدائه تحت قدميه’، ولكنها أيضًا (تختصّ) بترجمة إيمانهم ورجائهم في هذا الدهر، وذلك لأنّ مُلك الله – بالنسبة إليهم – هو في خلاص البشر الذي يبتدئ هنا في هذا العالم. وهذا يمنعنا منعًا باتًا مـن التمييز بين ما هـو عموديّ (إرضاء الله) وبين ما هو أفقيّ (الاهتمـام بالناس وحاجاتهم)، إذ كيف نهتمّ بالله إن لم نلقَ أبناءه كأخوة ؟ فالله هو أبونا جميعًا،. وفي السياق عينه يجب أن نفهم أنّ طلبة ‘الخبز الجوهري’ لا يتعلّق معناها بالخبز المادّي الـذي نأكله في هـذا العالم فحسب، ولكن أيضًا الخبز السماويّ الذي يعطيه الربّ للذين سيُجلسهم على مائدته الأخيرة وهي تحثّنا تاليًا على أن نطلب دائمًا جسد الربّ الذي نتناوله في القدّاس الإلهيّ .الصلاة الربّيّة هي صلاة الكنيسة التي أدركت أنّ المسافة بين الأرض والسماء قد زالت، وهي صلاة الغنج الأكبر الذي يهبه الروح القدس للذين يعملون بمشيئة الآب في كلّ زمان ومكان .
صلاة الربّيّة هي صلاة الكنيسة التي أدركت أنّ المسافة بين الأرض والسماء قد زالت، وهي صلاة الغنج الأكبر الذي يهبه الروح القدس للذين يعملون بمشيئة الآب في كلّ زمان ومكان .
آبانا
لا نريد، في هذا الشرح، أن نخرج عن الخطّ الذي رسمه التراث الأرثوذكسي، وأعني تأكيده القاطع أنّ الله هو فوق كلّ كلام وأبعد من أن تحبسه تحديدات ومفاهيم. ‘ فإله يمكن إدراكه ليس هو الله’. وهذا يعني أنّ إلهًا نزعم أنّنا نقدر على فهمه، عقليًا، بصورة كاملة، هو إله من اختراعنا، وليس هو الإله الحقيقيّ. غير أنّ هذا لم يمنع تراثنا من أن يؤكّد أيضًا، وفي السياق عينه، أنّ الله الذي لا يسعه مكان أو زمان ولا يمكن وصفه أو رؤية جوهره، هو إله شخصيّ، ومعرفتنا له تحدّدها كشوفاته في التاريخ، وتاليًا إيماننا به ومحبّتنا إيّاه. وذلك أنّ الإيمان ليس هو، في جوهره، حقيقة منطقيّة، بل علاقة شخصيّة وتسليم كامل لمن تنازل وبذل دمه حبًّا بنا.
انطلاقًا من تنازل يسوع ابن الله الوحيد الذي سمح لنا بأن ننادي أباه: ‘أبانا’، أن نكتشف – عمق هذا النداء الذي يحمل كلّ حقيقة الله، ويبيّن، تاليًا، اسس علاقة البشر بعضهم ببعض.
انّ بعض الآباء القدّيسين، أطلقوا لفظة ‘أبانا’ على الثالوث القدّوس. فالنداء، في مداه الأوّل، يدلّ، آبائيًّا، على العلاقة التي تربط الله المثلّث الأقانيم، وهو، تاليًا، يُدخلنا عمق معرفته. وليس هذا فقط، وذلك أنّ نداء ‘أبانا’ لا يضعنا في خطّ عموديّ حصرًا، ولكن أفقيّ أيضًا، أي إنّه لا يدلّنا على هذه العلاقة الثالوثيّة أو يطلب منّا اعترافًا بأنّ الله هو أبو يسوع أزليًّا فحسب، بل أيضًا على كون الله هو أبو جميع البشر، وأنّ ارتباط البشر بعضهم ببعض هو، بيسوع المسيح، ارتباط أخويّ.
يؤكّد القدّيس يوحنّا الذهبيّ الفم، في تعليقه على هذا النداء، يعلّمنا (يسوع في الصلاة الربّيّة) أن نجعل صلاتنا مشتركة، لمصلحة أخوتنا أيضًا. إذ لا يقول (المؤمن): ‘أبي الذي في السموات’، بل ‘أبانا’ مقدّمًا تضرّعاته من أجل الجسد المشترك، غير ناظر قطّ إلى مصلحته الخاصّة، بل إلى مصلحة قريبه في كلّ مكان‘.
وذلك لأنّ كلّ إنسان، هو ‘صورة الله’، والله تاليًا أعطى جميع البشر، بابنه يسوع، نعمة البنوّة، أي وهبهم أ لا يريدنا يسوع، فيما نخاطب الله، أن نكلّمه بمنطق العهد القديم ن يصيروا ‘أبناء الله‘. وذلك أنّ العهد الأوّل الذي أعطي في سيناء يلد العبوديّة(غلاطية 4: 24)، وجميع الذين أُخضعوا لشريعة الناموس كانوا عبيدًا (افسس 2 :15)، بل أن نعرف أو أن نقبل أن يقودنا روح الله إلى معرفة كوننا ‘أبناء الله’ المدلّلين، وأن ننادي الله بالطريقة عينها التي كان يلفظها الأطفال الآراميّون فيما كانوا يتدلّلون على آبائهم: ‘أبّا’ (أو كما نقول بلغتنا: ‘بابا‘)
قد نقلنا يسوع الذي يحقّ له وحده أن يخاطب أباه ببساطة كلّيّة وألفة حميمة (متّى 11: 25، 26: 39؛ مرقس 14 :36، 15: 34؛ لوقا 10: 21، 23: 46 وما يوازيها)، بنعمة روحه القدّوس، من حالة الخوف والبعد والجهل، وقرّبنا من الله أبيه، وأعطانا أن نناديه بجرأة الأطفال(بابا) من دون أن تطالنا دينونة (كما تدعونا خدمة القدّاس الإلهيّ).
الأبانا” التي علمها يسوع لتلاميذه اراد بها ان يكون كل تلميذ انسانا جديدا في علاقة جديدة مع الله وعهد جديد، وتاليا باستطاعته ان يقول يا “أبّا” حيث يصبح ابنا حقيقيا ولا يعود عبدا ويمنح الروح القدس بواسطة المعمودية فيصبح شبيها للخالق.
أبانا الذي في السموات
لا تعني عبارة ‘أبانا الذي في السموات’ أن الله ليس موجودًا في الأرض،(أو انّه بمعنى آخر، محدود في مكان). نقول في طقوسنا ‘ في كل مكان’.
الكنيسة الارثوذكسية ذهبت إلى أبعد من هذا ، ففي تعليمها، المتعلّق بالتجسّد ، أكّدت أن كل مسافة أو فرق بين الأرض والسماء، أو ما هو فوق وما هو تحت، ألغي في المسيح يسوع.
وهذا يمكن توضيحه بتأكيد آخر، وهو أنّ الله الذي هو، في جوهره، ‘غير مدنو منه’ (قد يكون هذا التعريف هو أحد أهمّ معاني عبارة ‘أبانا الذي في السموات’) هو إله محبّ (أنظر: إنجيل يوحنّا ورسائله). فالمحبّة هي التي تبسط حقيقة الله الأزلية وكلّ عمله الخلاصيّ في التاريخ.
وهذا يعني أنّ قلب الإنسان هو مسكن الله الحقيقي، ‘إنّ ملكوت الله في داخلكم’، يقول يسوع (لوقا 17: 21). ولعلّ كلامه الوارد في إنجيل يوحنّا يوضح ما نريد قوله هنا، وهو:’إذا أحبّني أحد حفظ كلامي فأحبّه أبي ونأتي إليه فنجعل لنا عنده مُقامًا’ (14: 23). فالقلب البشريّ هو، في العمق، سماء الله الحقيقيّة.
يعرف العارفون أنّ عبارة ‘الأب الذي في السموات’ كانت، في التقليد العبريّ، في زمن يسوع، تدلّ – رغم ندرة استعمالها – على تسامي الله وتعاليه وبآنٍ على قدرته وسلطانه في الأرض وعلى ‘كلّ الساكنين فيها’ (مزمور 24: 1).
والعبرانيّون، في كلّ حال، ما كانوا يجترئون على التلفّظ باسم الله أو مناداته بدالّة في صلواتهم الشخصيّة (فهذا عندهم يسيء إلى تسامي الله). أمّا يسوع ابن الله الوحيد الذي أتى ليحرّرنا من العبوديّة وينتشلنا من كلّ بعد وجفاف وخوف، فقد علّم أتباعه أن ينادوا أباه بحرّيّة ودالّة: ‘أبانا الذي في السموات’،
وذلك أنّه أراد أن يكشف أنّ الله هو أب حنون ومترئف لا بإسرائيل فحسب، ولكن بالبشر جميعًا. لقد فتح يسوع باب الملكوت لجميع البشر، وألغى كلّ مسافة وعرق وجنس ولغة، وذلك لأن السماء لا تظلّل أناسًا دون غيرهم، وأكّد، تاليًا، أنّ ما يطلبه الله من البشر جميعًا هو أن يثقوا برحمته وقدرته وأن يحيوا أخوة مع البشر كافة.
يقول ثيودورس أسقف مصّيصة في شرحه هذه الصلاة: ‘ أريدكم أن تقولوا أبانا الذي في السموات ‘حتّى تتمثّل أمام عيونكم، في الدنيا، الحياة السماويّة حيث أعطي لكم أن تنتقلوا يومًا. فإنكم – قد نلتم التبني – صرتم مواطني السماء.
أجل هذا هو المقرّ اللائق بأبناء الله’ وذلك أنّ المسيحيّين هم يعيشون في الأرض بموجب قانون موطنهم الحقيقيّ (السماء) الذي هو في قلوبهم. ولا يعني هذا أنّ المسيحيّين يحتقرون العالم أو ينفصلون عنه، ولكن أنّهم في العالم وليسوا منه،
هم يعبدون ‘الأب الذي في السموات’ بإخلاص دون غشّ، إخلاص يكون بإيمانهم وبطاعتهم للأب، وتاليًا رفضهم كلّ إغراء يصدر عن إبليس أو عن الذين يتبعونه.
فيا ‘أبانا الذي في السموات’ أعطنا أن نفهم حبّك وتنازلك وتعاليك هبنا روحك القدّوس لنعرف أنّك وحدك في قلبنا مالكًا وأنّنا بابنك الحبيب ارتقينا، من الأرض إلى السماء.
خلاصة: أنّه لدينا أبٌ ولسنا أيتامًا. والله أبانا سيلبي كلّ مطالب الصلاة بإيمان غير متزعزع به، لأنه ولا أيّ أب يحرم أبناءه من خيراته عندما يطلبونها منه. ونسمي الله أبـًا معترفين بالتبني، أي مستحقين ان نكون أبناءً بنعمة الله. كلّ خيرات الله التي سنحصل عليها بكوننا بعلاقة أخوية مع ابن الله الوحيد ونحصل موهبة الروح القدس. وبالتالي لنا شركة مع الثالوث القدّوس
بالحقيقة عندما نسمي الله أبًا فهذا يعني أنه يجب أن يكون لدينا انتماء وحياة، حتى لا نبدو غير مستحقين لهذا النسب الشريف.
أبانا”، ندّل أننا والآخرين إخوةٌ، ولسنا وحدنا فقط على الأرض، ولسنا نحن من لدينا الله أبًا، أي لسنا نحن وحدنا أبناء.
ليتقدّس اسمك:
تبدأ الطلبة الأولى في الصلاة الربيّة بدعوة المؤمنين إلى تقديس اسم الله (والاسم، في التقليد الكتابيّ، هو الشخص ذاته). هذه الصلاة تدلنا على ان الله هو الآب نفسه.
في العهد القديم عرّف الله عن نفسه بقوله:
‘أنا يهوه، هذا هو اسمي’ (خروج 3 :14-15، 6: 2-3).
واسم ‘يهوه’، في اللغة العبريّة، ليس، كما يقول أتباع بدعة ‘شهود يهوه’ اليوم، اسمًا علمًا، ولكن صفة، ويعني ‘الكائن’ أو ‘الذي يكون’ اي: ‘أنا هو مَن هو’).
فإذا قال الله: ‘أنا يهوه’، فهو يدلّ على كيانه الذي لا يُدرك، لذلك يستعمل العبرانيّون عادة، تجنّبًا للتلّفظ بالاسم المقدّس الذي أوحي به الله لموسى، عبارات أخرى، مثل: الأزليّ، السيّد، الكليّ القدرة، السموات، القدّوس والمبارك…).
ان هذا الاسم (يهوه) غير وارد في العهد الجديد، الا أن اسم ‘يسوع’ يعني، في اللغة العبريّة: يهوه يخلّص
وهذا ما يدفع الإنسان إلى أن يلتفت نحو الله ويعترف بقداسته فيلتزم عبادته ويمدحه ويسجد له (عدد 27: 14؛ تثنية 32: 51؛ اشعيا 8: 13). والله، تاليًا، عن طريق المفارقة، يدلّ على قداسته حين يشرك الإنسان فيها، يقول: ‘كونوا قدّيسين كما أنّي أنا قدّوس’ (أحبار 11: 14).
أما في العهد الجديد فالله يكشف عن ذاته بصفته أبًا قدّوسًا ، هو أب لابن وحيد أرسله من أجل أن يخلّص الإنسان الذي انفصل عنه بارتكابه الإثم، وأن يهبه التبنّي ويعيده إليه، وذلك أنّ ‘إرادة الله قداسة البشر’ (1 تسالونيكي 4: 3)، وهذا يعني أنّه يريد (ويعمل من أجل) أن يلتفت الناس إليه، بمحبّة كليّة، وأن يعلّوا قداسته بقبولهم عطاياه في كلّ أقوالهم وأعمالهم (أنظر: أفسس 1: 3 و4)، وأنّه يريدهم، تاليًا، أن ينشروا قداسته في الأرض، أو، كما يقول القدّيس كيرلّس الإسكندريّ في شرحه هذه الطلبة، أن ‘يشفعوا من أجل كلّ سكّان الأرض’.
ويسوع هو قدّوس الله، وقد قدّس الكنيسة لمّا مات عنها (يوحنا 17: 19؛ افسس 5: 26 وعبرانيين 9: 13، 10: 10،14 ،29، 13: 12).
يقول القدّيس يوحنا الذهبيّ الفم:’جدير بالذي يدعو الله أبًا أن يصلّي لا ليطلب شيئًا قبل مجد أبيه، بل أن يحسب كلّ الأشياء ثانوية بالنسبة إلى عمل تسبيحه’،
‘هكذا فليضئ نوركم (أي إخلاصكم لله الذي تعيشونه في شركة الكنيسة) للناس، ليروا أعمالكم الصالحة، فيمجّدوا أباكم الذي في السموات’ (متى 5: 16).
أمّا إذا أتينا نقيض هذا فإنّنا نسيء إلى الله وقداسته، ‘أي إنّ كلّ الغرباء عن إيماننا يقولون عنّا، وهم يشاهدوننا منصرفين إلى أعمال سيئة: ليسوا أهلاً لأن يكونوا أبناء الله’،. فالله، في الأخير، يُعرَف وتظهر قداسته في المؤمنين الذين لا يساومون على محبّته.
الخلاصة:
. وعندما نصلّي “ليتقدس اسمك” لا يعني أن اسم الله ليس قدوس، فهذه الطلبة لها معنيان، الأول “ليتقدّس” أي “ليتمجّد” اسمه ويتمجّد بحياتنا الشخصيّة، ويجدَّف على اسم الله عندما لانكون أوفياء لاسمه ونصون هذا النسب الشريف. أما المعنى الثاني للكلمة ليس مستقلاً أبدًا عمّا سبق، فالكلمة “ليتقدّس”، أيّ “اجعلنا قديسين”، نطلب من الله أن يقدّس حياتنا الشخصيّة.
فبهذه الطلبة ندّل على ماهيّة هدف الإنسان ولأي سبب يعيش. هدفه أن يتحد مع الله ويصير قدّيسًا بنعمة وقوى الله. الله بحسب الطبيعة قدّيسٌ، وعلى البشر أن يصيروا قدّيسين بحسب النعمة. هذا ما يدعى التأله،”صيروا قدّيسين كما أنا قدّوس” (1بط16:1). هناك أناس يحاولون أن يبرّروا أنفسهم بقولهم: “هذه الحياة المقدّسة ليست لي، أريد أن أعيش هذه الحياةَ ببهجتها ولن أحرم نفسي أبدًا من عطاءاتها الأرضيّة الدنيويّة”. “لست قديسًا حتى لا أغضب”.
وبما أنّ حياتنا لا توافق هذه الوصية، ونحن لا نجاهد لكي نعيش بحسب مشيئة الله، فلهذا مسيرتنا هي ضدّ المسيحيّة. نحن مملوئين من الأهواء والحقد والوشايات والذنوب، ولهذا السبب، فإنّ الناس الآخرين يروننا ولا يؤمنون بالله، وبهذا نصير سبباً ليجَدّف على اسم الله في الأمم.
عندما نصلّي لله كما هي العادة، فنحن ندعوه أن يعطينا الصحة والرفاهية والخيرات الماديّة ….الخ، وهذا ما يجب أن نفعله، ولكن قبل ذلك علينا أن نصلّي لله كي يقدّسنا. فنحن نعرف أن لا شيء يتمّ بعيدًا عن مشيئتنا. فعلينا إذاً أن نقدّم حريتنا ليتمجّد اسم الله في العالم.
ليأتِ ملكوتك
أو ‘ ليأتِ روحك القدّوس’، كما يقول نصّ قديم لإنجيل لوقا. وملكوت الله هو قوّة الله ونوره وفرحه ونعمته وملكه…. ولقد بدأ حقًّا، حسب شهادات الكتب المقدّسة، في التاريخ الخلاصيّ (ولو أنّ الشرور، في كلّ وجوهها، مازالت موجودة في العالم)، وهو سيُعلَن كاملاً في اليوم الأخير، وفق الوعد الصادق. في الطلبة الأولى صلّينا ‘ ليتقدّس اسمك’، وتقديس اسم الله، هو الذي يحضّ المؤمنين على أن يستعجلوا حلول ملكوته كاملاً.
غير أنّ هذا لا يعني، حصرًا، أنّ إخلاص المخلصين هو الذي يدفع الله إلى أن ينهي ‘أزمنة الناس’، فقد يكون العكس هو الصحيح (أنظر: لوقا 8: 18؛ متّى 24: 12)، بل إنّ حياتهم الصادقة هي، في جوهرها، كشف لهذا الملكوت العظيم وامتداد له.
والواقع أنّ يسوع ردّد، في بدء كرازته، ما قاله يوحنّا المعمدان قبله ( والأنبياء عمومًا تناولوا، بوجه خاصّ، موضوع ‘مُلك الله’…)، وهو: ‘ توبوا فقد اقترب ملكوت الله’ (متّى 3: 2-4: 17 وما يوازيها). وهذا – في نداء يسوع – يعني أنّه حضر.
أن نؤمن بحضور الملك يعني أن نقبل ملكوته وننتسب إليه. فليس ملكوت الله أرضًا أو سماء، ولكنّه شخص المسيح الذي ‘فيه صرنا أبناء’، وليس هو، تاليًا، حدثًا أخرويًّا فحسب، وذلك أنّ ‘ما لم تره عين أو تسمع به أذن أو يخطر على بال بشر’ (1كورنثوس9: 2)،
يمكن أن يذوق المؤمنون ومضاته هنا في هذا الدهر، وأن يمتشقوا إلى كماله، وذلك في طاعتهم برَّ الله وفي نشوة الأسرار المقدّسة وحياة الشركة. لقد ظنّ بعض الناس أنّ يسوع جاء ليؤسّس مملكة أرضيّة. وفي الواقع أراد بعضهم أن يختطفوه ليقيموه ملكًا (يوحنّا 15 :6).
المفاهيم القديمة (الحروب والويلات والاستعمار الرومانيّ…) ساهمت في هذا التفكير واستعجال اليوم الأخير. وذلك أنّ الناس الأتقياء تجعلهم الأزمنة الرديئة أن ينتظروا تغيير أوضاعهم، أو أن يُبطل الله، بحضوره، الزمان والمكان ليحلّ عدله.
والعبرانيّون ذاقوا قديمًا خبرة حكم الله، وقد أعطاهم الله – بعد أن ألحّوا عليه – أن تكون أرض إسرائيل مملكة زمنيّة يحكمها ملك يمثّل الله. وكانت السقطة. وتتالت الخيبات.
جاء يسوع، وأسقط كلّ المفاهيم المغلوطة. ورفض رفضًا قاطعًا اقتراح إبليس الذي عرض عليه أن يملك على ‘جميع ممالك الدنيا ومجدها’ (متّى8: 4 و9).
وكشف أنّ ‘مملكته ليست من هذا العالم’(يوحنّا 18: 36). وأدان كلّ تحريف أو ترقّب للملكوت الأخير ليس مؤسّسًا على ‘السهر’ (اليقظة) وطاعة الله. وذلك أنّه أراد أن يكشف مرّة وإلى الأبد أنّ الملكوت فيه، وليس هو شيئًا آخر.
ولعلّ أصرح تعبير عن حقيقة الملكوت الذي أتى يسوع يعلنه ‘ومكانه’ (إذا جاز التعبير)، هو قول الربّ في إنجيل لوقا: ‘ملكوت الله في داخلكم’ (17 : 21)، وهو يريد أن يقول إنّ المؤمنين بي يشدّهم حبّهم إلى الملكوت الآتي، أو إنّ حبّهم ذاته يجعلهم يذوقون، في هذا الدهر، ما يرجونه في اليوم الأخير،
أو، بلفظٍ آخر، هم الذين يدركون أنّ الهدف الرئيس في حياتهم هو أن ‘يمتلكوا الله في نفوسهم’، لا يعني أن يحتجزوه ‘في حياتهم الشخصيّة الضيّقة’، ولكن أن يعملوا ويناضلوا ‘لكي ينشروه في ما حولهم’، وذلك أنّ الله الذي لا تهمّه الممالك والسلاطين يطلب قلوب البشر.
وهل أحلى من الصلاة عندما تكون حكاية؟ تكلّم يسوع كثيرًا، في أمثاله، على هذا الملكوت المدهش الذي فيه (استعمل يسوع عبارة ‘ملك الله’ 90 مرّة من أصل 120 في العهد الجديد)، وكشف أنّه عطيّة الله (يسوع هو عطيّة الله) وأنّه موهبة مجّانيّة يغدقها الله بابنه على الذين يوافقون بطاعتهم إرادة الروح ويحيون بعمقٍ فاعلٍ شركة نعم، إنّ يسوع حقّق ملكوته بإتمامه تدبير أبيه، ونحن ننتظر أن يظهره تامًّا في يومه، ولهذا نصلّي برجاء كبير: ‘ آمين! تعال أيّها الربّ يسوع’ (رؤيا يوحنّا 22: 20). غير أنّ تعاليم يسوع حول الملكوت تبيّن، تاليًا، أنّ أنوار هذا الملكوت المدهش تضيء في العالم الذي مازال البشر فيه يريدون للشيطان سلطة، وذلك ليعرف الجميع أنّ كلّ إنسان – مهما عظمت خطاياه – قادر، إذا شاء حرًّا أن يرمي عنه رداء العار، على القيام والتجدّد، وذلك لأنّ نور الربّ يشرق على ‘المقيمين في بقعة الموت وظلاله’.
حين يصلّي المسيحيّون ‘ليأت ملكوتك’ فهم يوجّهون أبصارهم نحو اكتمال الملكوت راجين اعتلانه هنا بتقويض سلطة إبليس وخلاص البشرالكنيسة (محبّة الله و الأخوة).
من إحدى شروحات مجيء ملكوت الله، أن يأتي الحضور الثاني للمسيح سريعًا، أيّ أن يأتي المسيح ليدين البشر، وهذا يعني أن يأتي ذلك اليوم الذي ستقوم فيه كلّ أجساد البشر وتبدأ دينونتهم.
يحنّ المسيحيون الأوائل والمؤمنون إلى هذا الملكوت، ويشتهون مجيء المسيح ليتحدّوا معه كما في الزواج، طالما هم يمتلكون الآن العربون الروحي. وهذا بالضبط يشترط نقاوة داخليّة وضمائر صاحية. ومن الجدير ذكره أن الرسل يوضّحون في رسائلهم أن ملكوت الله قريب، للذين يعيشون اسخاتولوجياً. ينتهي كتاب رؤيا يوحنا بالصرخة “تعال، أيها الرب يسوع” (رؤيا :20). أمّا التفسير الآخر لـ”ليأت ملكوتك”، أن تأتي نعمة الله في قلوبنا بقول المسيح “ملكوت اللّه فيكم” (لو20:17). وكلمة “فينا” لا تعني بيننا بل في قلوبنا.
ملكوت الله داخلنا، يأتي عندما نفتح قلوبنا ونقبل نعمة الله بطرق متنوعة. هذا يبدأ بالتوبة، فنعمة الله تُحرق الأهواء ونشعر بها كقوة لاذعة. تزداد هذه النعمة ببهجة وفرح داخليّين عندما يذكر الإنسان اسم الله باستمرار ويصلّي إليه، عندئذٍ يستنير ذهنه ويشعّ. وبالنهاية عندما يكون الإنسان مستحقاً أن يرى الله في نوره حينئذٍ يرى ملكوت الله.
ويظهر هذا في الانجيل المقدس ، فقبل تجلي المسيح قال لتلاميذه: إنّ البعض بينكم لن يموتوا ليروا ملكوت الله الذي سيأتي “بقوة”. وبعد هذا بقليل أخذ منهم ثلاثة تلاميذ وأصعدهم إلى جبل ثابور وتجلّى أمامهم. عندئذٍ رأى التلاميذ وجهه مضيئاً كالشمس و أصبح رداؤه ناصع البياض كالنور، وبحسب تفسير الآباء رؤية المسيح هذه داخل النور كانت رؤية ملكوت الله.
يجب أن نطبّق ملكوت الله في حياتنا، علينا أولاً ان نقبله في قلوبنا بقوى الله المطهّرة والمنيرة والمؤلِّهة. وبعد هذا سنتذوقه في المستقبل. والعكس صحيح أيضاً، فعندما نرغب بالمجيء المستقبلي لملكوت الله سنشتهيه وهذا يقودنا إلى التوبة وتذوق الملكوت في هذه الحياة. في الوقت الذي أتى فيه ملكوت الله بتجسد المسيح، ويأتي بالتوبة وشركتنا مع المسيح، وسيأتي بالحضور الثاني.
لتكن مشيئتُكَ كما في السماء كذلك على الأرض
لتكن مشيئتُكَ كما في السماء كذلك على الأرض ليست مشيئة الله في السماء ‘إرادة حقوقيّة’، بل هي ‘خلاص العالم’ (راجع: يوحنّا 6 : 39- 40؛ وأفسس 1: 3 – 10)، هي ‘دفع تدفّق حياة، ما يعطي الوجود ويجدّده عندما يتيه’. وهذه المشيئة كشفها الله الآب، في ملء الزمان، في ابنه يسوع الذي لم يكن فيه ‘نعم ولا، بل نعم وآمين’ (2 كورنثوس 1 : 19)، وهي التي تطيعها الملائكة في السماء (مزمور 103: 20)، وتعلّيها صلوات القدّيسين (رؤيا 11: 4)، وهي، في الأخير، ما يريد الله أن تظهر في الكنيسة المجاهدة قبل أن يستقبلها في ملكوته الأخير بعد أن تكون قد تخلّصت من كلّ ما يناهض مشيئته.
غير أنّ قصده يتحقّق، في العالم، من خلال جوابنا نحن البشر وطاعتنا له كأبناء أحبّاء. فهو يريدنا قدّيسين (1تسالونيكي 4 : 3). ولقد أعطانا روحه ليقوّم تقاعسنا ويقوّي فينا كلّ عزم لنكون موافقين وعاملين ‘في سبيل رضاه’ (فليبي 2: 13؛ عبرانيّين 13: 21).
لقد رأينا في طلبتَيْ: ‘ليتقدّس اسمك’ و’ليأتِ ملكوتك’، أهمّيّة أن يكون الإنسان منفتحًا على متطلّبات الله في حياته. وهنا، في هذه الطلبة، نجد المعنى عينه، وذلك أنّ مشيئة الله لا تتمّ في الأرض كلاميًّا فحسب، ولكن بالفعل أيضًا، أي بطاعة الحياة.
هذا ما أظهره يسوع في جثمانيّة’ إذ صلّى قبل آلامه بثقة كاملة واستسلام كامل وحرّ لمشيئة الله أبيه، استسلام هو، في حقيقته، تعبير عن خضوعه لأبيه وتواضعه أمامه (قال: لتكن مشيئتك لا مشيئتي).
الربّ، في هذا النزاع الأخير، لم يطلب أن ينجّيه أبوه من الموت القريب، بل أراد أن يدلّ على تجاوبه وإرادةَ أبيه. وهذا ما يطلبه الربّ من الذين يرغبون بأن يعرفوا الله مخلّصًا وقدّوسًا: أن يتشبّهوا بيسوع فيثقوا بالله مهما كانت ظروفهم صعبة، ويبتعدوا عن كلّ شرّ يهاجمهم ويصلحوا أنفسهم دائمًا على ضوء رحمته ومحبّته (أنظر: رومية 12 : 1- 2).
ما يبيّن، إذًا، أنّنا قَبِلْنا هذه الطلبة هو أن نتخلّى عن مشيئتنا. وذلك لأنّ ‘من يتخلَّ عن مشيئته فهو قدّيس’، كما يقول أبونا البارّ يوحنّا السلّميّ (المقالة 9/17).
وهذا (أن نتخلّى عن مشيئتنا) لا يعني، بالطبع، أن نكون بلا مشيئة، ولكن أن تصبح مشيئة الله هي إيّاها مشيئتنا. فالذين يطلبون مشيئة الله حقًّا هم أولئك الذين لا يقيمون وزنًا لما في هذا العالم من مغريات، وهم الذين مهما اشتدّت عليهم التجارب والمحن، لا يهادنون ولا يساومون على الحقّ، بل يقبلون النعمة التي أعطيت لهم بالمسيح الذي خلّص العالم من كلّ شرٍّ وموت لمّا استسلم كلّيًّا لمشيئة أبيه.
لا يُكرهنا يسوع على شيء، فهو لا يطلب منّا أن نقبل إرادته غصبًا عنّا، ولكن بحرّيّة تامّة. والحرّيّة هي صورته فينا. يريدنا أن ننفذّ إرادته لأنّه ربّنا، ولأنّه يعرف مصلحتنا أفضل منّا. لا يُكرهنا الله على شيء، لأنّنا أبناؤه، ولسنا عبيدًا. العبد ( قد) لا يقتنع دائمًا بما يريده سيّده، ولو نفّذ إرادته.
أمّا الابن فيعرف أنّ أباه يحبّه فيطيعه في كلّ حال، ولو قسا عليه يعرف أنّ قسوته وجه من وجوه حبّه إيّاه. صحيح أنّ الأبرار يستعبدون أنفسهم لله (لوقا 17: 10)، ولكنّه هو لا يراهم عبيدًا، بل أبناء، يقول يسوع: ‘لا أدعوكم عبيدًا بعد اليوم، لأنّ العبد لا يعلم ما يعمل سيّده. فقد دعوتكم أحبّائي لأنّي أطلعتكم على كلّ ما سمعته من أبي’ (يوحنّا 15: 15).
أنّ بعض علماء التفسير رأوا أنّ عبارة ‘كما في السماء كذلك على الأرض’ لا ترتبط بهذه الطلبة حصرًا، ولكن بما سبقها أيضًا.
وهذا ما أوحى به قديمًا العلاّمة أوريجانس بقوله: ‘يمكننا أن نفهم عبارة متّى (كما في السماء كذلك على الأرض) بمعنى أوسع. فالصلاة المطلوبة منّا هي كالتالي: ليتقدّس اسمك كما في السماء كذلك على الأرض، ليأت ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. فاسم الله قدّسه سكّان السماء؛ وملك الله أقيم فيهم؛ وإرادة الله تحقّقت فيهم. فكلّ هذه الأشياء التي هي ناقصة لسكّان الأرض، بوسعها أن تتحقّق إذا عرفنا أن نكون أهلاً لأن يستجيب الله لنا’.
ولكن لا يمكن أن تجري مشيئة الله على الأرض تمامًا وكمالاً كما هي في السماء، وذلك لسبب بسيط، وهو أنّ الأرض ليست كاملة، أبديّة، نهائيّة كما هي السماء.
الأرض مسيرة أمّا السماء فغاية. الأرض مؤقّتة تتكامل باستمرار وتتحسّن بغير انقطاع. أمّا السماء فهي نهاية، تكميل، كلّيّة.
في الأخير، تكشف لنا هذه الطلبة خلاص الله الـذي صالح، بمـوت ابنه وقيامته، السماء والأرض (السماويّين والأرضيّين) ووحّدهما به.
خبزنا الجوهريّ أعطنا اليوم
المسيح يعرف أننا نحن بشر وأجسادنا تحتاج إلى الغذاء المادي، فالمسيح أخذ جسدنا البشري وآكل مثل البشر، بالرغم من أنّه لم تتحرك فيه الحاجة للطعام والشراب. لكن الإنسان بحاجة إلى هذا الغذاء المادي لا كما يحدث مع الملائكة في السماء الذين ليس لهم أجسادٌ ولا يتغذون ماديًّا.
وهكذا بينما في الطلبة السابقة للصلاة الربانيّة علّمنا المسيح أنّه علينا أن نعيش كالملائكة، هتا في الطلبة الآتية ينعطف إلى مرضنا ويعلّمنا أنّه يجب أن نصلّي إلى الله “أبانا” من أجل خبزنا اليومي، فالإنسان لا يشبه الملائكة في كلّ شيء طالما أن له جسدًا ويجب أن يأكل. لهذا علّمنا المسيح أن نطلب من الله أن يهبنا الخبز اليومي.
في افتتاحية الصلاة، تكلّم المسيح عن الخبز وليس عن المال والترف والحياة الراغدة والألبسة الفاخرة. ويعلّمنا في هذه الطلبة أن نطلب من الله الضروريّات، وأن لا نهتم للخيرات الماديّة الكثيرة المتراكمة.
خبزنا الجوهريّ أعطنا اليوم
أنّ هذه اللفظة، ‘جوهريّ’ (epiousios) في هذه الطلبة. التي استعملت في العهد الجديد حصرًا في الصلاة الربّيّة، يمكن أن تعني، في أصلها اليونانيّ، حسب اشتقاقاتها المتنوّعة: الخبز الضروريّ للعيش ( خبزنا اليوميّ )، الخبز من أجل المستقبل، أو خبز الغد…، أو الخبز الجوهريّ.
الخبز الجوهريّ وهذا المعنى الأخير هو الذي تستعمله كنيستنا الأرثوذكسيّة وتجده أكثر توافقًا وسياق الصلاة الربّيّة.
هذا الخبز يُقال عنه بأنّه “الجوهري” أي الضروريّ لطبيعة الجسد، الضروريّ لجوهر حياتنا المعيشية، اليومي. طالما أنّ الخبز اليومي هو ضروري لكفايتنا. والمهم أن نطلب من الله أن يهبنا إيّاه بكثرة
ومع أنّ كلّ حصر لا يرى في هذه الطلبة سوى طلب الحاجات الأرضيّة هو ناقص، فإنّ طلبة الخبز الجوهريّ لا تهمل طلب حاجات الإنسان الضروريّة للحياة.
فإذا قال الربّ صلّوا: ‘خبزنا… أعطنا’، فهو يريد منهم أن يتوجّهوا إليه معترفين به إلهًا وسيّدًا على حياتهم، وأن يثقوا بفعله وخلاصه في زمانهم الحاضر. يعلّمنا يسوع، في إنجيله، أن نتّكل على الله وحده في كلّ شيء (اطلبوا تجدوا، اقرعوا يُفتح لكم…). أن نتّكل عليه في كلّ شيء، أو أن نسلّم حياتنا له، هو أن نستلمها منه.
نقول ‘خبزنا… أعطنا’، والخبز هو من ضرورات، هذه الحياة. يسوع يريدنا دائمًا أن نطلب الخبز، في صلواتنا، من الله أبينا لنتعلّم أن نكون أمامه كالأطفال الذين ينتظرون كلّ شيء منه (متّى 7: 9 وما يوازيها).
أن نطلب، إذًا، من الله خبز اليوم أمر يقينا من الاتّكال على ذواتنا حصرًا، أو أن ‘ ننهك أنفسنا باهتمام اليوم التالي’. فيسوع لا يريدنا أن نهتمّ بالغد أو بأيّ ملك أرضيّ، بل أن نؤمن بعناية الآب المطلقة (متّى 6: 25- 34)، بعنايته بنا ‘اليوم’.
يعلّمنا المسيح بهذه الطلبة أن نلقي عنّا الاهتمامات الكثيرة والكبيرة. ولهذا عنى بقوله: “اليومي”، فلا يجب على المسيحي أن يكدّس الخيرات الماديّة كما فعل الغني الغبي في المثل الذي قاله لنا المسيح، لأنّه بهذه الطريقة يشير من جهة أنّه ليس عنده محبة للأخوة، ومن جهة أخرى ليس لديه ثقة بعناية الله، لكن يثق بنفسه بشكل مطلق وهذا عمليًّا هو عدم إيمان وتجديف.
وهذا ما يؤكّده أيضًا القدّيس كيرلّس بقوله: ‘ فالربّ إذ أوصاهم أن يسألوا من أجل الخبز، أي من أجل خبز يوم واحد. فهذا برهان واضح على أنّه لا يسمح لهم بامتلاك أيّ شيء، بل يطلب منهم أن يمارسوا الفقر اللائق بالقدّيسين’. ويقول أيضًا: ‘إذًا فلنسأله ونحن ‘ ملقون كلّ همّنا عليه’ (1بطرس 5: 7) ما يكفي لحياتنا، أي الطعام والكساء متجنّبين كلّ رغبة في الغنى. لأنّ ذلك يهدّد حياتنا بالدمار، وإن كانت هذه هي إرادتنا فإنّ المسيح يقبلنا ويباركنا’.
عناية الله الآب بنا حقًّا ‘اليوم’ بيّنها يسوع بخاصّة في حادثة تكثير الخبز في البريّة (متّى 14: 14- 21)؛ الخبز الذي قدّمه أصلاً أناس من أجل غيرهم؛ فتكون، تاليًا، إرادة يسوع في تعليمنا أن نطلب الخبز هي أن نتحسّس جوع الآخرين وقلقهم وأن نطعمهم من ‘خبزنا’، أن نسدّ جوع أخوتنا المنتشرين حولنا وفي العالم من عطايا الله.
فهذه الطلبة لا تسمح للمسيحيّ بأن يعتقد أنّ الخبز الذي يطلبه من الله هو خبزه الشخصيّ فحسب، بل ‘خبزنا’ أيضًا، أي خبزه وخبز أخوته في آنٍ.
يرفعنا هذا القول الأخير إلى أن نرى في طلبة ‘خبزنا الجوهريّ أعطنا اليوم’ معنى أعمق من طلب الحاجات الأرضيّة، لأنّ يسوع الذي قال ‘ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان’ (متّى 4: 4) يريدنا ‘اليوم’ أن نطلب ‘الخبز الجوهريّ’، وهذا، كما فهم الآباء عمومًا، يدلّ على كلمة الله التي يقرأها المؤمن في الكتاب المقدّس ويجدها في تعليم الآباء القدّيسين وفي مقرّرات المجامع المسكونيّة، وعلى ‘الخبز النازل من السماء’، أي ‘يسوع الإله المخلّص الذي يقدّم لنا جسده ودمه في سرّ الشكر (المناولة)’
اذا يجب أن لا نهتّم بالخبز المادي فحسب، بل بالخبزَين الروحيين الآخرين، ألا وهما كلمة الله وجسد المسيح.
كلمة الله هي وصايا الله التي يجب أن نحفظها في حياتنا اليومية. وهكذا، وبهذه الطريقة نحصل على نعمة الله الكامنة وسط هذه الوصايا. في تجربة المسيح الأولى في الصحراء. فبعد الجوع، أغراه الشيطان أن يحوّل الحجارة إلى خبز. ولكن المسيح أجابه كما هو معروف بالقول: “ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكلّ كلمة تخرج من فم الله” (مت4:4). أيّ أنّ الإنسان لا يعيش فقط بالخبز المادي، بل بكلّ كلمة تخرج من فم الله.
(بالمثل الشعبي: “كلامك أشبعني)
أما الخبز الجوهري الثاني فهو الخبز الشكراني، جسد المسيح ودمه الإلهيين. فالمسيح دعا نفسه الخبز الذي نزل من السماء “أنا هو الخبز الحيّ الذي نزل من السماء (يو50:6 ). الذي هو أسمى من المَن الذي أكله اليهود في الصحراء. ولهذا حددّت الكنيسة أن ننشد “أبانا” في القداس الإلهي قبل وقت قليل من المناولة الإلهية لجسد المسيح ودمه الكريمين. ويعني هذا أنّه في هذه الطلبة يقدّم الخبز الروحي والسماوي الذي يكفينا ويقدّسنا وهو جسد ودم المسيح.
ذلك أراد يسوع أن ينشد أتباعه أوّلاً الحياة الأبديّة، وأن يعكسوا توقهم إليها في حياتهم اليوميّة، وأن يسمحوا للمحبّة بأن تغلبهم ليسود الملكوت في هذا ‘العالم الحاضر الخدّاع’ وتحلو الحياة لمن غلبه اليأس، ويرجو.
يريدنا يسوع في هذه الطلبة أن نحبّ ملكوت الله، لأنّه هو وحده الحقيقة الواقعيّة الذي نرى ومضاته في محبّة الله والناس، بخاصّة أولئك الذين وحّد يسوع نفسه بهم وجعلهم مرقاتنا إلى وجهه المنوَّر.
واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه”
يتكلّم العهد القديم كثيرًا على مغفرة الخطايا. فالله الذي لا يحبّ الخطيئة ويجرحه ابتعاد شعبه عنه وتصلّب رقابهم، هو إله رحيم ومترئّف بشعبه، ويحبّهم كما يحبّ الأب أبناءه والعريس عروسه (هوشع 2: 1؛ إرميا 2: 2؛ حزقيال 16 و23)، وهو يعدهم بالمغفرة والحياة إذا قبلوا دعوته وعادوا إليه بالتوبة
العهد الجديد، فيكشف لنا أيضًا صورة الآب الغفّار والحنون الذي أرسل ابنه إلى العالم لينقذ الناس من شقائهم ويطّهرهم، بموته وقيامته، من خطاياهم ويلبسهم حلّة جديدة، هي إيّاها حلّة العرس. والحقّ أنّ الربّ ترك لنا كلّ ‘ما علينا’، لا بل حمله هو (1بطرس 2: 24)، لمّا عُلّق مصلوبًا كشف أنّ محبّة الله تفوق بما لا يقاس كثرة خطايانا،وأنّ هذه المحبّة تطالنا فعلاً إذا سمحنا لله بأن تسكن رحمته فينا، وتركْنا نحن أيضًا بدورنا ‘ لمن لنا عليه’.
وإذا فكّرنا قانونيًّا، فإنّ اعترافنا بذنوبنا يعني أنّنا لا نستحقّ مغفرة الله، بل عقابه. ولكنّ محبّة الله تمنعنا من أن نفكّر على هذا المنوال، لأنّ منطقه يخالف منطق هذا العالم وقوانينه. فهو يغفر للناس لأنّه يحبّهم، وليس لأنّ البشر يستحقّون (رومية 5 : 8).
وهذا الفعل عينه يريدنا الربّ أن نترجمه مع الآخرين، وذلك أنّ من يقرّ بخطاياه لا يرى خطايا البشر شيئًا. وليس هذا فقط، ولكن أن نعرف أنّ كلّ شرّ يرتكبه أحد بحقّنا، ليس هو بشيء أمام الشرور التي نرتكبها نحن بحقّ الله.
فالله يريدنا أن نغفر للآخرين ذنوبهم كما غفر لنا المسيح (أفسس 4: 32؛ كولوسي 3: 13)، وهو يرتّب غفرانه الأخير على أساس غفران البشر بعضهم لبعض.
عظمة هذه الطلبة أنّها تحضّ المؤمنين على أن تكون أخلاقهم شبيهة بأخلاق أبيهم السماويّ.
وإذا عدنا إلى موقع الصلاة في إنجيل متّى، نجد أنّ الربّ بعد أن علّم أتباعه هذه الصلاة، قال لهم: ‘ فإن تغفروا للناس زلاّتهم يغفر لكم أبوكم السماويّ، وإن لم تغفروا للناس لا يغفر لكم أبوكم زلاّتكم’ (6: 14- 15). وهذا يفترض أن يتحمّل أتباع يسوع الحقيقيّون، في أحيان كثيرة، الظلم وأن يبتعدوا عن الحقد ويتنازلوا عن كلّ انتقام (أنظر متّى 5: 39- 40). فالرحمة واجبة في كلّ حال، وهي واجبة قبل الذبيحة.
يقول الربّ: ‘ فإذا كنتَ تقرّب قربانك إلى المذبح وذكرت هناك أنّ لأخيك عليك شيئًا، فدعْ قربانك هناك عند المذبح، واذهب أوّلاً فصالح أخاك، ثمّ عُدْ فقرّب قربانك’ (متّى 5: 23- 24).
وهذا يؤكّد أنّ الشركة مع الله تمرّ عبر مصالحة القريب، هذه المصالحة التي لا يؤجّلها أمر ولا حتّى تقديم العبادة لله نفسه.
نقرأ: ‘فدنا بطرس وقال له: ‘يا ربّ، كم مرّة يخطأ إليّ أخي وأغفر له؟ أسبع مرّات؟’ فقال له يسوع: لا أقول لك: سبع مرّات، بل سبعين مرّة سبع مرّات’ (متّى 18: 21- 22).
هناك أربعة عناصر لكلّ صلاة: التمجيد والشكر والتوبة والتضرع. هذا الذي نراه في الصلاة الربانيّة. فمع الطلبة الخامسة لهذه الصلاة نقول: “واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه”. نتضرع إلى الله أن يسامحنا على خطايانا التي ارتكبناها. كما نحن نغفر إساءاتهم إلينا.
عندنا أمران يرتبط أحدهما بالآخر. الأول أنّه يجب أن نطلب المغفرة من الله عن خطايانا التي ارتكبناها، وبهذا يرشدنا إلى التوبة. والأمر الثاني أنه يجب علينا أن نتميّز بعدم حفظ الإساءة للغير ويشير المسيح أننا سنحصل بها أيضًا على غفران خطايانا.
محبة الله الكبرى للبشر بأنّه مستعدٌ لأن يغفر خطايانا إن نحن التجأنا إلى محبته بسرعة. فليس الله إلهٌ مجبرٌ، بل هو إلهُ المحبة والرأفات والرحمة،. فكثيرًا من الأحيان نقول في الكنيسة: “لأنّك إلهٌ رحيمٌ ومحبٌ للبشر”.
فإن نحن غفرنا زلات إخوتنا، عندئذٍ أيضًا سيغفر الله خطايانا. بهذه الطريقة يجب أن نُظهر نحن محبةً للبشر وعدم حفظ الإساءة لهم. وأن يتبّع ذلك موقف الله. إن كان الإنسان قاسيًا على إخوته، عندئذٍ لا يستطيع قلبه أن يشعر بالمحبة وبمحبة الله للبشر. يحبّ الله كلّ العالم-الصالحين والخطأة- لكن قساة القلوب لا يستطيعون أن يشعروا بمحبة الله لهم. وبغفراننا للآخرين نطهّر القلب ونهيئه لأن يشعر بمحبة الله للبشر. مطلبنا
نطلب من الله في القداس الإلهي الغفران عن كلّ أخطائنا. لكن يجب أن نكون جاهزين أن نسامح إخوتنا بغفراننا لهم على ما عملوه معنا. وبما أنّ الصّلاة الربانيّة (أبانا) التي تقال قبل المناولة الإلهية لجسد ودم المسيح بقليل، لذا كانت هذه الصلاة بمثابة تهيئة للمناولة. مع استعدادنا لمناولة الأسرار الطاهرة نطلب من الله الغفران للخطايا التي تمّ الاعتراف بها، لأنّ هذه الصلاة لا تستطيع أن تلغي سرّ الاعتراف المقدّس، لكنّها تؤكد بنفس الوقت لله على أن نعطي نحن أيضًا الغفران للذين أساؤوا إلينا وأضرّوا ووشوا بنا. ولكن يجب أن ننتبه ألاّ نعطي وعودًا كاذبة لله ففي مثل هذه الحالة نحن نخاطر بأنفسنا وبغفران خطايانا الكثيرة.
ولا تُدخلنا في تجربة لكن نجّنا من الشرّير
هي آخر طلبة في الصلاة الربّيّة. السؤال الذي يطرح ذاته، هو: ما هي التجربة التي يطلب المؤمن من الله ألاّ يدخله فيها ? من هو المجرّب؟ والجواب عن هذين السؤالين سنبيّنه في ما يلي.
في الكتاب المقدس وردت كلمتان متناقضتان بمعنى التجربة، هما: الامتحان والإغراء.
الامتحان، هو طريقة تأديبيّة يمرّر الله فيها الإنسان لينقّيه كما ينقّى الذهب والفضّة
هو (الامتحان)، إذًا، فرصة تساعد الإنسان على أن يكتشف إيمانه وتقوده إلى أن يحيا لله وحده.
وأمّا الإغراء فهو حركة تردّد في النفس البشريّة بين النعمة الإلهيّة والخطيئة.
المغري دائمًا هو الشيطان (أو الشهوة التي في داخل الإنسان)، وهي، بهذا المعنى، دعوةٌ إلى الموت (يعقوب 1: 13- 15؛ أنظر أيضًا: 1كورنثوس 7: 5؛ )
وهذا (الإغراء الذي مصدره الشيطان) هذا هو معنى التجربة في هذه الطلبة.
هذه المقدّمة تردّ على الذين يتبادر إلى ذهنهم أنّ الله هو الذي يجرّب (يغري) الناس. فالله قدّوس ولا يمكن أن يعمل عمل الشيطان (سيراخ 15: 11 و12).
ولكن، يقول بعض: إنّنا نتوجّه إلى الله في هذه الصلاة، ونقول له: ‘لا تدخلنا في تجربة’. جوابنا هو: أنّ هذه العبارة لا تعني لا تجرّبنا، بل تعني، لا تسمح بأن ندخل، أن نقع ونسقط، ويمكننا أن نترجم النصّ اليوناني هكذا: ‘لا تجعلنا، أو لا تدعنا ندخل في تجربة.
وكأنّنا نقول لله: لا بدّ من أن نُجرَّب (متّى 4: 1، 16: 22- 23، 26: 36 وما يوازيها)، لأنّك تريدنا أن نختارك أحرارًا، فلا تتخلّى عنّا وساعدنا في وقت المحنة، لأنّ الشرّير المغلوب لم يُبطل إغراءه، وأنت يا ربّنا ‘نجّنا منه’.
وهذا يعني أنّ أحدًا في الأرض لا يمكنه أن يختار الله سيّدًا على حياته ومعينًا له في شدائده ومحنه ومدافعًا عنه في أوقات التجربة إلاّ حرًّا.
بيد أنّ هذه الطلبة تفيد أيضًا، وبشكل خاصّ، ازدياد الشرّ في ‘آخر الأزمنة’، حيث يبلبل الشيطان وعبيده أفكار المؤمنين ليوهم الضعفاء بأنّه هو سيّد الكون.
وهذه التجربة هي واحدة من أقوى التجارب التي يمكن أن تواجه الإنسان، لأنّها يمكن أن توحي إليه بأن الله يتفرّج على الناس في محنهم ولا يتدخّل. فمن مثل هذه التجربة التي تقود إلى الجحود نطلب النجاة (لوقا 22: 31 و32).
ولذلك فإنّ الإنسان المؤمن مدعوّ إلى أن ينضمّ إلى يسوع الغالب بموته وقيامته، ليخوض حربًا طاحنة ضد الخصم الأكبر (الشيطان) الذي يسعى إلى استعباد البشر.
وهذه الحرب التي لا هوادة فيها سلاح المؤمن فيها غلبة الربّ ذاتها التي نذوق بركاتها في السهر وطاعة كلمة الله وهذا يفترض إيمانًا عميقًا واتّكالاً كاملاً على الله الذي ‘بدونه لا نستطيع شيئًا’.
فالله هو الذي يحمي شعبه من إغراء الخطيئة ويدافع – معهم – عنهم ليثبّت في الأرض مخطّط حبّه دائمًا.
يقول الرسول بطرس في رسالته الأولى ‘
كونوا قنوعين ساهرين. إنّ إبليس خصمكم كالأسد الزائر يرود في طلب فريسة له، فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أنّ أخوتكم المنتشرين في العالم يعانون الآلام نفسها. وإذا تألّمتم قليلاً، فإنّ إله كلّ نعمة، الإله الذي دعاكم إلى مجده الأبديّ في المسيح، هو الذي يعافيكم ويثبّتكم ويقوّيكم ويجعلكم راسخين’ (5: 8- 10).
ثمّ إنّ الله لا يسمح بأن يجرَّب الإنسان فوق طاقته (1كورنثوس 10: 13؛ 2تسالونيكي 3: 3). وهذا يعني أنّه يمنحه، في ظروفه الصعبة، نعمة ابنه الحبيب (عبرانيّين 2: 10- 18)، ليتمكّن من أن ينتصر على كلّ شرّ يداهمه.
يريدنا يسوع، في هذه الطلبة الأخيرة، أن نلتمس من الله الآب عونه ورضاه وحمايته من كلّ شرّ وشرّير يتربّص بنا في العالم. وهذا ما يلتقي وصلاة يسوع التي رفعها إلى الله أبيه من أجل تلاميذه في عشيّة موته، إذ قال: ‘لا أسألك أن تخرجهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير’ (يوحنّا 17: 15).
اذا في هذه الطلبة يريد منّا المسيح أن نطلب من الله الآب كي يخلصنا من الشرير.
الشيطان ليس قوة وهميّة، وليس حالة الشرّ لكنّه شخص خاص؛ فقد كان ملاكًا وفقد الشركة مع الله فأصبح روحًا مظلمة. جاء المسيح إلى العالم ليُبطل أعمال الشيطان “لأجل هذا أُظهر ابن الله لكي ينقض أعمال ابليس” (1يو8:3). ظهر الشيطان في الصحراء ليجرّب المسيح، وقد خلق عثراتٍ كثيرًة. وهذا ما رآه كثير من القدّيسين وحاربوه بقوّة المسيح.
في هذه الطلبة للصلاة الربانية، يُوصَفُ الشيطان بالشرير، وتدّل هذه الكلمة على معانٍ كثيرة.
– الشّرير هو ذاك الذي يتعذب بالجسد من الأتعاب لأن هذه الصفة تأتي من الفعل أتألم
– وتدّل على التعاسة والشرّ والدناءة .
– “كليّ المكر” الذي يستخدم كلّ شيء ليجعل الإنسان دائمًا بعيدًا عن الله.
دعا المسيح الشيطان شريرًا كما في مثل الزارع،). ودعوة الشيطان بالشّرير يدّل أن الشرّ ليس حالة طبيعية لطبيعتنا، بل هو نتيجة اختيارنا.
لم يجبل الله الإنسان لأن يكون سيئًا، بل هذا الشرّ قد دخل كنتيجة للخطيئة، وللعصيان لله الخيّر وإطاعًة للشيطان الشّرير.
المَكر صفة معروفة للشيطان أيّ عنده شرّ بالغ، هو يحاربنا باستمرار دون أن نظلمه. الشيطان شّرير في طبيعته، لهذا لا يستطيع أن يتوب. بينما الإنسان يتوب ويقبل محبة الله.
وصف المسيح الشيطان بالشّرير ليعلّمنا أنّه لا يجب أن نتخاصم مع البشر لأيّ سبب سببوه لنا، لأنهم ليسوا هم من يهاجموننا بل الشيطان سبب الشرّ. فهو يحرّض البشر أن يؤذونا. ولهذا ينبغي علينا أن نحوّل عداءنا إلى الشيطان وليس إلى الناس. شرّ الشيطان كبير. وهو ماكرٌ أيضًا، ومحتال، يعمل فينا لأن نخطئ ونبتعد عن الله.
الحرب الكبيرة للشيطان ضدّ الإنسان التي تُظهر شرّه هي حرب الأفكار. شرّه هو حرب الأفكار. وبسبب هذا بالضبط يتعلّم الإنسان في الكنيسة مواجهة الأفكار، وبهذا الأمر يتمّ التدريب.
يستطيع الإنسان أن يجد الطرق التي يحارب الشيطان بواسطتها. وطبعًا يلعب الأب الروحي دورًا مهمًا في هذا. ومن الطرق ايضا لمحاربة الشيطان بالاحتقار الذي يتمّ بالإيمان بالله، أو بطردها وخاصة بصلاة يسوع “ياربّ، يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ”، وبتنمية الأفكار الصالحة تجاه كلّ مطلب من الإنسان.
بهذه الطلبة للصلاة الربّانية، يعلّمنا المسيح أن نطلب من الله أن يخلّصنا من الشّرير، فالشيطان لديه قوة كبيرة وخبرة كثيرة، أما الإنسان فضعيف وعديم القوة. الله وحده يستطيع أن يساعدنا في هذه الحرب طالما أنّ المسيح انتصر على الشيطان وأعطى الإمكانيّة لكلّ إنسان بقوته أن ينتصر عليه.
لأنّ لك الملك والقدرة والمجد
تختم الصلاة الربّيّة بتسبيح ليتورجيّ وهذا التسبيح يخصّ المؤمنين جميعًا، ولو أنّ الكهنة يعلنونه وحدهم في الخدم الليتورجيّة.
أنّ هذا التسبيح أنّه يدعونا إلى إتمام الصلاة بالتضرّع إلى الله المثلّث الأقانيم.
فبعد أن عظّمنا، في الصلاة التي علّمنا إيّاها يسوع، الله في سماواته وقدّسنا اسمه وطلبنا حلول ملكوته وعاهدنا مشيئته ورجونا فرحه الأخير (هنا في حياتنا أيضًا) وغفرانه وحمايته، نسبّحه، ثالوثًا، كملك وقدير ممجّد، نسبّحه لأنّ إتمام ما قلناه (في الصلاة الربّيّة) يخصّه، لأنّه القادر على أن يساعدنا عليه. فالصلاة الربّيّة لا يمكن لأحد من الناس أن يتمّمها بقدرته الذاتيّة، ولكن بنعمة الله ودعمه. نختم الصلاة، إذًا، بتسبيح. والتسبيح أحد عناصر الصلاة الحيّة.
يبدأ هذا التسبيح بلفظة ‘لأنّ’، التي تؤكّد أنّ الله الذي توّجهنا إليه في الصلاة الربّيّة قادر على إعطائنا ما طلبناه، لأنّنا أبناؤه، ولأنّ ما طلبناه هو ضمن إمكاناته.
الملك، (‘ملكوته يسود الجميع’) يفيد سيادة الله على الخليقة، علينا، كملك، وهو ما رجوناه في طلبة ‘ليأت ملكوتك’. تاليًا، أنّ الله هو ‘ملكهم قبل الدهور’ الذي ‘يصنع الخلاص في الأرض’ وينقذهم من براثين الشرّير.
أمّا قدرة الله والمجد فتدلّ على صفات ملكه ، التي يظهرها في إحسانه على خليقته الحرّة. هي ليست قدرة متهكّمة أو متعسّفة، ولكنّها القدرة التي تبيّن أن الله صالح في جوهره وصالح في تدبيره الخلاصيّ.
اذا كلمة “القدرة” لها قوة روحيّة، فهي قدرة المحبة وقوة الروح القدس، وليس لها أيّة علاقة بالقدرة العالمية التي تتزين بالأسلحة والأشياء الدنيويّة. إنما يتعلّق هذا الأمر بقدرة الصليب، وقدرة الصليب بظاهرها تبدو ضعيفة لكنها تُبطل كلّ قوة وسلطة عالمية. هذه القوة هي قوة الروح القدس، لهذا قال المسيح لتلاميذه “ستنالون قوةً متى حلَّ الروح القدس عليكم” (أع8:1). وبهذه القوة انتصروا عل كلّ قوى العالم.
وإذا قلنا لله ‘لك المجد’ فإنّنا نريد مـن قـولنا أن نؤكّد أنّ الله صانعنا وفادينا. هو، الآن وكلّ أوان وإلى دهـر الداهرين، مجيد في ذاته وفي ما يعمله في العالم.
مجّد المسيح ألوهيتُه وبهذا المجد تستنير نفوس المسيحيين “هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجّد الله في وجه يسوع المسيح” (2كور6:4). فالذين يشتركون بمجّد الله، يتمجّدون، ولا يكَرَّمون بشكل بسيط بل يستنيرون من نعمة وقدرة الله.
ونريـده أن يكون مجيدًا في قلوبنا التي لا يمـلك عليها إن لم نقدّمها له أحرارًا كأبناء حقيقـيّين. وهـذا يفترض تعهّدًا منّا بأنّنا لن نخون حبّه أبدًا. وأنّنا سنلتزم تسبيحه وعبادته في كلّ وقت.
فمن له مثل هذا الأب الذي لديه ممملكة وقدرة ومجّد وهو مدّبر العالم ومحبٌ للبشر، لا يستطيع أن يضيّع رجاءه أو يضطرب حتى وإن تندّى من التجارب الكبيرة الصعبة.
إن الصلاة الربانيّة “أبانا” هي صلاة قوية، لها معنى روحي، ولأن المسيح علّمنا إياها. لها فعاليّة لأنّها تشير إلى محبة ومجّد الله. نطلب من خلالها الخيرات الروحيّة، وأن تتغيّر أعمالنا، وعلاقتنا وشركتنا مع الله، وأن ننتصر على التجارب والشّرير، وغفران خطايانا. علينا دائمًا أن نصلّي هذه الصلاة لأنّ المسيح سلّمنا إيّاها بالوصيّة القائلة: “فصلّوا أنتم هكذا، أبانا الذي في السموات…..” (مت9:6). ويجب علينا أن نصلّي بانتباه وتركيز الذهن إيمانًا بالله. ولنا رجاء أكيد أن الله يسمعنا ويحمينا ويحبّنا. فهي صلاة تبدأ باستدعاء الله أبًا وتنتهي بتسبيح ملكوت الله وقدرته ومجده.
ونختم هذا الإيمان بالتضرع بقولنا: “آمين”، والتي هي كلمة عبريّة، أما في اللغة اليونانيّة فتُشرح الكلمة بمعنى “حقيقةً، أو حقاً”.
فعندما تستعمل “آمين” في العبادة تؤكد تثبيت الشعب في الصلاة وتدّل على بركة الكاهن، وتفسَّر بـ”ليكن هذا” أو “لعلّه يحدث”.
في رؤية يوحنا اللاهوتي، وُصف المسيح بـ”الآمين” أيّ “الرّب الصادق”، “هذا يقوله الآمين الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله” (رؤ14:3).
اخيرا عندما نصلّي الصلاة الربانية وفق هذه “الروح” التي أوردناها سابقًا، سنرى عجائب في حياتنا وستتجدّد أعمالنا ونؤهلّ أن ندخل ملكوت الله ومجد الفردوس في الحياة الأبديّة.