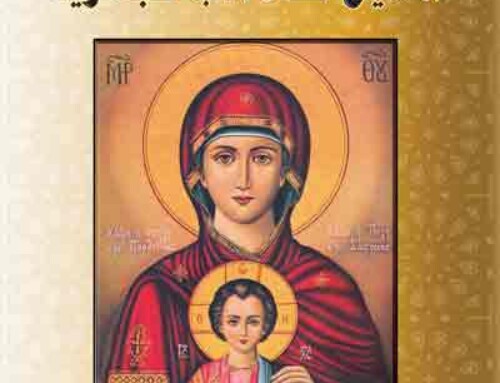عظة للقدّيس يوحنا الدمشقي
(سلسلة أناجيل ورسائل الآحاد –ج6- صفحة 908-924)
1- “ذكر الصدّيقين تحفّ به المدائح” (أمثال 7:10)، يقول سليمان الجزيل الحكمة، “وعزيز في عينيّ الربّ موت أتقيائه” (مز 15:115)، كما تنبّأ داود جدّ الإله. فإذا ما كانت المدائح تحتفّ بذكر جميع الصدّيقين، فمن لا يقتضي بمدح من هي ينبوع الصلاح وكنز القداسة، لا لزيادتها مجداً، بل لكيما يزداد هو نفسه من المجد الأبدي؟ هيكل الله، مدينة الله، ليست بحاجة البتة إلى تمجيد من جهتنا: فلأجلها نُطق بعبارات مجد، كما يقول لها داود الإلهي: “بالأمجاد يا مدينة الله يحدَّث عنك” (مز 3:82). كيف نفهم لَعمري “مدينة الله” هذه، التي لا ترى ولا تحدّ والتي تحوي كل الأشياء في يدها (أشع 12:40)، إن لم تكن تلك التي استطاعت وحدها بالحقيقة أن تحوي كلمة الله الفائق الجوهر في عظمته التي لا حدّ لها، بحال تفوق الطبيعة والجوهر؟ تلك التي لأجلها قال الربّ نفسه كلمات مجيدة؟ وأيّ شيء أمجد من تقبّل تصميم الله؟
تقدمة النيّة الطيّبة
2- إذ ليس باستطاعة لغة بشريّة أو ذهن الملائكة الذين يفوقون العالم أن يحتفلوا كما يليق، بتلك التي أُعطي لنا بها أن نشاهد بجلاء مجد الرب. ولكن ماذا؟ أو َنسْكُتُ لكوننا غير قادرين على الإشادة بها كما يليق، وهل يُعيقنا الخوف لذلك؟ كلاّ بالطبع. أو هل نُقدم على تخطّي العتبة، كما يقال، من دون أن نعرف حدودنا الذاتية لنلمس القدسيّات من دون احتراس، غير عابئين برادع الخوف؟ لا البتّة. بل بالحريّ لنشبك الخوف بالحب ولنصنع من تشابكهما إكليلاً واحداً، وبتكريم قدوس ويد مرتجفة ونفس مضطرمة، لنقدّم بواكير فكرنا المتواضعة كدَين عرفانا بالجميل، للملكة والأمّ، المحسنة إلى الطبيعة برُمَّتها.
يُحكى أنّ فلاّحين كانوا يشقّون الأثلام مع ثيران الحراسة، فرأوا ملكاً ماراً، عليه لباسه الأرجوانيّ الرائع متلألأ بلمعان تاجه، وكان وسط حشد لا يُحصى من الحرّاس المحتفّين به. ولمّا لم يكن في متناولهم شيء البتة حينئذ يمكنهم تقديمه كهدية للملك، راح واحد منهم وبدون انتظار فجلب ماء في يديه (كان يجري بوفرة بالقرب منهم) وحمله كهبة للملك. فقال له الملك: “ما هذا يا بنيّ؟” فأجاب بثقة: “ما كان في تصرّفي، أتيتك به. فكّرتُ أنه الرأي الأفضل: فالعوز لا ينبغي أن يُخمد حماسنا. ليس لك ما تفعل بهباتنا، لكنك لا تريد سوى إرادتنا الطيبة. وهذا الصّنيع هو واجب بالنسبة إلينا، كما أنه أيضاً لمدحنا، لأن المجد يواكب ذوي السّخاء بطيبة خاطر”. فعجب الملك لهذه الحكمة ومدحها، وتقبل هذه الإرادة الطيبة بلطف، وعزم على مكافأة الرجل بعطايا جسيمة. فإذا كان هذا الطاغية المتكبّر قد فضّل النيّة الطيبة على غنى التقدمة، فلكم بالأكثر تتقبل نيتنا من دون النظر إلى مقدرتنا، هذه السيدة الصالحة حقاً، أم الله الصالح وحده الذي لا نهاية لتنازله والذي يفضل “الدرهمين” على التقدمات الغنية؟ بدون أدنى شك، سوف تتقبل تقدمة هذا الدّين وتعطينا بالمقابل خيرات لا مثيل لها في عظمتها. وهكذا، بما أن كل شيء يدفعنا إلى الكلام، ولكيما نضطلع بما يتوجب علينا، لنوجّه الكلام إليها إذن.
3-بأي لقب ندعوك أيتها السيدة؟ وبأية تعبير نحييك؟ بأية مدائح نكلّل جبينك المقدّس المملوء مجداً، يا موزعة الخيرات ومانحة الثروات، يا جمال الجنس البشري وفخر الخليقة بأسرها، يا من بها اغتبطت هذه الخليقة بالحقيقة؟ فها الذي لم تكن تحويه قبلاً بالفعل، بك أصبحت تحويه. وذاك الذي لم تكن لها القوة للتحديق به، أصبحت “تشاهده كما في مرآة، والوجه سافر” (2كو 18:3). افتح يا كلمة الله فمنا البطيء في التكلم، وضع على شفاهنا المفتوحة كلمة مملوءة نعمة. انفخ فينا نعمة الروح التي بها صيادون وضعفاء يُصبحون بُلغاء، وبها ينطق أُمّيون بحكمة تفوق الإنسان، كيما ينجح صوتنا الواهي بدوره، ولو بغموض، في إذاعة عظائم أمّك المحبوبة جداً.
تدبير الخلاص
فهي التي اختبرت في الواقع منذ الأجيال الغابرة بسابق اختيار الله الآب وعطفه، الذي ولدك خارج الزمن من دون أن يخرج من ذاته ومن دون تغيّر، هي التي ولدتك آخذاً منها جسداً “في الأزمنة الأخيرة” (1بط 20:1)، أنت الكفّارة والخلاص، العدل والفداء، الحياة الخارجة من الحياة، “النور من النور، الإله الحق من الإله الحق”. ولادة هذه الأم كانت فائقة على طور الطبيعة، ولادتها تجاوزت الطبيعة والعقل البشريّ، وكانت خلاصيّة للعالم. ورقادها كان مجيداً، مقدّساً بالحقيقة وأهلاً لمديح دينيّ.
لقد سبق الآب فاختارها، ثم كرز بها الأنبياء بالروح القدس. ثم زارتها فضيلة الروح المقدسة فطهرتها وقدستها، وروّت من ثم هذه الأرض. أنت إذاً، يا من هو “التعريف بالآب والتعبير عنه”، أتيت وسكنت فيها من دون أن تصبح محصوراً، لكي تذكّرنا بذّل طبيعتنا البالغ أمام السمو اللامحدود الذي للألوهة غير المدركة. ومن هذه الطبيعة البشرية أخذت بواكير الفائق العفاف والساّمي الطهارة والبريء من العيب الذي للعذراء القديسة، وصنعت لك جسداً ونفساً عاقلة وناطقة وحفظتها لك في ذاتك. فصرت إنساناً تاماً من دون أن تبرح إلهاً تاماً مساوياً لأبيك في الجوهر، بل أخذت ضعفنا على عاتقك كحنوّ لا ينطق به ثم خرجت منها، أنت المسيح الواحد والربّ الواحد والابن الواحد، إلهاً وإنساناً معاً، إلهاً تاماً وإنساناً تاماً في آن، إلهاً كاملاً وإنساناً كاملاً بالكلية، أقنوماً واحداً ذا طبيعتين كاملتين: إلهية وإنسانية. ليس مجرد إله أو إنساناً فحسب، بل كابن واحد لله وإله متجسد، إله وإنسان معاً في الأقنوم عينه من دون امتزاج ولا انفصال: المخلوق وغير المخلوق، المائت وغير المائت، المنظور وغير المنظور، المحصور واللامحدود، المشيئة الإلهية والمشيئة الإنسانية، الفعل الإلهي ومعه أيضاً بالتأكيد فعل إنساني، كلاهما حرّ، الإلهي كما الإنساني، الآيات الإلهية والآلام البشرية، أعني الآلام الطبيعية وليس الناتجة عن ذنب.
لأن آدم الأول الذي لكونه قبل التعدي حراً من الخطيئة، اضطلعت به أيها السيد بجملته، جسداً ونفساً وروحاً مع كافة ملكاته الطبيعية لكيما تُنعم بالخلاص على كياني برمّته، بسبب أحشاء رحمتك، لأنه صحيح جداً القول إن “ما لم يُضطلع به لا يبرأ”. وبحصولك “وسيطاً بين الله والناس”(1تيم 5:2)، نقضت الكراهية وقدت إلى الآب من تركوه: أعدت من ضلّ وأنرت من أظلم وجددّت ما تحطّم، وحولت إلى عدم الفساد من فسد. ومن الاعتقاد الخاطئ بتعدّد الآلهة نجّيت الخليقة، وجعلت البشر “أبناء لله” وأعلنت من كانوا في الهوان مشاركين في مجدك الإلهي. والمحكوم عليه في الجحيم السفلي أنهضته “فوق كل رئاسة وسلطان” (أف 21:1). ومن حُكم عليه بالعودة إلى الأرض والسّكنى في أرض السكوت، أجلسته على العرش الملكي فيك أنت نفسك. فمن كانت إذاً واسطة هذه الخيرات التي لا تقدر والتي فوق كل فكر وفهم؟ أو ليست تلك التي ولدتك، الدائمة البتولية؟
4- أنتم ترون، أيها الآباء والأبناء المحبوبون من الله، نعمة هذا النهار الحاضر. ترون كم هي سامية ومكرّمة من نحتفل بها. أو ليست أسرارها رهيبة؟ أو ليست مملوءة بالآيات؟ طوبى للذين يرون كل ما يجدر في تأملها، وطوبى للذين يملكون حس الإدراك. “فبأي نور وأية ومضات قد استنارت هذه الليلة! وأية طغمات ملائكية أشعّت رقاد الأم التي كانت مبدأ الحياة! وبأية تعابير إليهة يطوّب الرسل دفن الجسد الذي اقتبل الإله! كيف كلمة الله الذي لرحمته قبل أن يُصبح ابنها، يخدم بيديه السيديتين، هذه المرأة الإلهية الفائقة ال قداسة، كيف تُخدم أم ويتقبل نفسها المقدسة! يا للمشترع الكامل! فالذي لا يخضع للناموس، طبق الناموس الذي حمله هو نفسه، إذ هو الذي أمر بواجب الأولاد تجاه أهلهم بقوله: “أكرم أباك وأمّك” (خر 12:20) إنها حقيقة ظاهرة لمن تلقّن ولو بشكل واه الوحي الإلهي الذي في الكتاب المقدس. فإذا صح قول هذا الكتاب الإلهي إن “نفوس الأتقياء هي بيد الرب” (حك 1:3)، فلكم بالأحرى هذه ، لا تسلم نفسها بين يدي ابنها وإلهها؟ إنها حقيقة أكيدة فوق كل اعتراض.
ولكن، أتريدون أن نقول أولاً من هي وما أصلها وكيف أُعطيت للعالم كعطية العطايا التي من الله العليّ والفائق اللّطف في آن، وكيف عاشت في الحياة الحاضرة وأيّ أسرار أُهّلت لها؟ لنشرح هذه النقاط إذاً.
تكريماً للأموات، كان اليونانيون يجمعون بعناية تامة كلَّ ما كانوا يجدونه مفيداً في الرثاء، وذلك لينطبق التأبين على البطل المحتَفل به من جهة، ولكي يكون حافزاً للأحياء ودافعاً لهم تحاه الفضلية من جهة أخرى – وكانوا ينسجون خُطبهم عموماً من حكايات وقصص خيالية لا عدّ لها، إذ لم يكن لشخصياتهم ما يؤلّفونه بأنفسهم من أجل المسيح. في هذه الأحوال، إذا ما أخفينا في لجج الصمت، حسب التعبير الجاري، ما هو صحيح وجدير بالوقار بشكل مطلق، وما لوجوده حقاً إضفاء على الجميع بركة وخلاصاً، كيف لا نستوجب الاستهزاء التام، والحكم عينه الذي وقع على من أخفى وزنته؟ لكنّا سنحرص على اقتضاب الخطبة خوفاً من أن تتعب الآذان، كما يسبب ضرراً للأجساد إسراف في الغذاء.
جدّا المسيح يواكيم وحنّة
5- يواكيم وحنّة كانا والديها. وكان يواكيم، كراع للنّعاج، يسوق أفكاره كما تُساس القطعان، ويحرسها تحت سلطانه ويقودها كما يشاء. إذ لكونه هو نفسه كالنعجة، والرب الإله كالراعي، لم يكن يعوزه أي خير سام. ولا يتصوّرون أحد أني أدعو خيرات سامية هذه الأشياء التي يفكر بها الأكثرون والتي يصبو إليها دائماً فكر البشر الكثيري الجشع، التي لا تدوم بطبيعتها ولا تستطيع أن تجعل صاحبها أفضل حالاً مما هو عليه: متع الحياة الحاضرة هذه، التي لا يمكنها الحصول على قيمة ثابتة بل تضمحل من ذاتها وتتبدد حالاً، حتى ولو سيحصل عليها بكثرة. لا، ليبتعد منا الفكر الذي يُعجب لها! فهذا الأمر ليس نصيب الذين يتقون الرب. ولكنني أتكلّم على الخيرات المشتهاة حقاً والتي يودّها البشر المستقيمو الحكم، الخيرات التي تدوم إلى الأبد، التي تبهج الله وتهب مالكيها ثمراً في أوانه: أعني بذلك الفضائل التي تعطي ثمرها في أوانه، أي الحياة الأبدية في الدهر الآتي، لهؤلاء الذين على أي حال سيجتنونها كما ينبغي، في عملهم بأنفسهم وحسب قواهم. العمل يسبق، وتتبعه البهجة الأبدية. لقد اعتاد يواكيم أن يجلب أفكاره الخاصة إلى الداخل“في مراع خضر” (مز 2:22) – حيث يمكث في تأمل كلمات الوحي المقدسة – و“نحو المياه الهادئة” (مز 3:22) التي للنعمة الإلهية حيث كان يجد لذّاته. كان يحوّلها عن الباطل ويرشدها إلى “سبل الحق”.
أما حنّة والتي اسمها يعني “نعمة”، فكانت شريكته في تقاليده كما في تفاعل الحياة. كانت تحظى بكل الخيرات، بيد أنها، ولسبب خفي، قد بُليت بألم العقم. في الواقع، كانت النعمة عقيمة، لا قوة لها كي تثمر في نفس البشر: “لأنهم ضلّوا كلّهم وفسدوا جميعاً” (مز 2:13)، “وما من أحد عاقل يطلب الله” (مز 3:13). وكان الله ينظر عندئذ بصلاحه مشفقاً على عمل يده ومريداً أن يخلّصه، فوضع حداً لعقم النعمة، أي حنّة الإلهية الأفكار: فوضعت في العالم طفلة لم تولد قبلها أخرى ولن تولد أبداً. وأظهر شفاء هذا العقم بكل وضوح أن عقم العالم، العاجز عن انتاج الخيرات، قد توقف هو نفسه وأن جذع الغبطة المحظورة راح يثمر.
6- ولهذا أتت والدة الإله في وقتها بقوة وعد: ملاك يعلن الحبل بتلك المزمعة أن تولد. إذ كان يليق في هذا المجال أيضاً ألا تتنازل لأحد، ولا أن تأتي بالدرجة الثانية تلك التي كان عليها أن تلد بحسب الجسد الإله الوحيد والكامل حقاً. ثم قُدمت لتُكرس لله في هيكله المقدس: هنا عاشت وأعطت القدرة في غيرة وسلوك أكمل وأطهر من الآخرين، بعيداً عن أية علاقة بالرجال والنساء البعيدين عن الخير. ولكن، لكونها قد أذوت رَيَعان شبابها، وبما أن الشريعة تمنع البقاء طويلاً في حضن المكان المقدس، عُهد بها من قبل جوق الكهنة إلى يدي زوج يحافظ على عذريتها، إلى يوسف الذي كان يحفظ الشريعة في طهارته حتى بلوغه النضوج وأكثر من أي (إنسان) آخر. عنده عاشت هذه الفتاة القديسة البريئة من كل عيب، تهتم بالأعمال البيتية من دون أن تعلم شيئاً البتة مما يجري أمام بابها.
بشارة الملاك
7- “ولما بلغ ملء الزمان” (غلا 4:4) كما يقول الرسول الإلهي، أرسل الله الملاك جبرائيل إلى تلك التي كانت بالحقيقة ابنة لله، وقال لها:“إفرحي أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك”. كلام عجيب من الملاك موجّه إلى تلك التي تسمو على الملاك، جلب الفرح إلى الكون بأسره. بيد أنها “اضطربت لهذا الكلام” لكونها غير معتادة على الاختلاط بالرجال، ولأنها كانت عازمة بشدة على حفظ بكارتها. “وقالت في نفسها: ما معنى هذه التحية؟ “فقال لها الملاك عندئذ: “لا تخافي يا مريم فقد نلت حظوة عند الله”. نعم في الحقيقة، نالت حظوة من هي أهل للحظوة. نالت حظوة من عملت وحرثت حقل النعمة، وحصدت سنابل وافرة (الثمر). نالت حظوة من أنتجت بذار النعمة وحصدت من النعمة الغلّة الوفيرة. نالت لجة من النعمة، تلك التي حفظت سفينة البتوليتين سالمة. إذ كانت تسهر في الواقع على طهارة نفسها، لا أقل مما على طهارة جسدها، وقد حُفظت بتوليتها الجسدية نفسها.
وقال لها (الملاك): “ستلدين ابناً تسمينه يسوع – ويسوع يعني مخلّص – فهو الذي يخلّص شعبه من خطاياهم” (لو 31:1)، فماذا أجابت “كنز الحكمة الحقيقي” على هذه الكلمات؟ إنها لم تقتد بحواء، أمها الأولى، بل بالحري قوّمت سلوك هذه الطائش، فتستّرت وراء حماية الطبيعة، واتخذت هذا الحديث نوعاً ما بمثابة جواب على كلام الملاك: “كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلاً؟” ما تقوله مستحيل: كلامك يقلب نواميس الطبيعة التي ثبتها خالقك. لا أقتنع بأن أقوم بدور حواء ثانية ولا أن أخالف مشيئة الخالق. إذا كنت لا تتكلم ضد الله، أشرح لي كيفية الحبل لكيما يزول ارتباكي. فقال لها ملاك الحق عندئذ: “الروح القدس يحل عليك، وقدرة العلي تظللك، لذلك فالقدوس الذي يولد منك يُدعى ابن الله”. السر الحاصل ليس خاضعاً لنواميس الطبيعة، لأن مكوِّن الطبيعة وسيّدها يعدّل كما يشاء حدود الطبيعة. (وهكذا)، تجاه الاسم الإلهي المكتنف على الدوام بالحب والعزة، والذي سمعته باحترام مقدس، نطقت الممتلئة مخافة وفرحاً بعبارات الطاعة: “أنا خادمة الرب، فليكن لي كما تقول“.
8- “فيا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه! – سأستعير هنا كلمات الرسول – ما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه” (رو 33:11). يا لعظم صلاح الله! يا حباً يفوق الوصف! “الذي يدعو غير الموجود إلى الوجود” (رو 17:4)، الذي هو “مالئ السماوات والأرض” (إرم 24:23)، الذي“السماء عرشه والأرض موطئ لقدميه” (إشع 1:66)، يتخذ لذاته مسكناً رحباً من حشا خادمته الخاصة ويُنجز فيها سر الكل الأكثر جدة. فكونه إلهاً، صار إنساناً، ولما بلغ زمان ولادته، وُلد بحال تفوق الطبيعة، فقد فتح الحشا الأمومي من دون أن يفض ختم بكارتها. وعلى أيد بشرية، حُمل كطفل صغير، هو “بهاء مجد الآب وصورة جوهره” (عب 3:1)، الذي يحفظ الكون برمّته بكلمة فمه.
فيا للعظائم الإلهية حقاً، والأسرار التي تفوق الطبيعة والعقل! يا لامتيازات البتولية التي تفوق الإنسان! ما هذا السر العظيم الذي يكتنف أيتها الأم القديسة والبتول؟
رموز العهد القديم عن العذراء
“فأنت مباركة في النساء ومبارك ثمر بطنك”. أنت مطوبة من أجيال الأجيال، ووحدك أهل لأن تدعَى طوباوية. فها كل الأجيال تطوبك في الواقع، كما سبق فأعلنت. وبنات أورشليم، أي الكنيسة، رأتك فهنأتك، والملكات اللواتي هنّ نفوس الصدّقين سيباركنك إلى الدهور. لأنك العرش الملكي الذي يقف الملائكة بجانبه متأملين سيّدهم وخالقهم الجالس عليه. فقد أصبحت عدناً الروحية، الأقدس والأكثر تألهاً من (عدن) القديمة. في الأولى سكن آدم (الأرضي)، وفيك إنما هو الرب الذي “من السماء” والتابوت سبق فصورك، يا من خلّصت زرع الخليقة الثانية: لأنك ولدت المسيح خلاص العالم، الذي غرّق الخطيئة وسكن أمواجها.
وكانت العلّيقة من قبل رسماً لك، والألواح المكتوبة من الله صورتك، وتابوت العهد تحدث عنك. جرة الذهب، والشمعدان، والمائدة”، و“عصا هارون التي أورقت” قد سبقت فأظهرتك. ومنك ولد في الواقع من هو شعلة الألوهة، “التعريف بالآب والتعبير عنه”، المنّ اللذيذ والسماويّ، الاسم الذي لا اسم له والذي “يفوق كل اسم”، النور الأبدي الذي لا يدنى منه”، “خبز الحياة” الآتي من السماء”، الثمرة المجتناة من دون عمل: منك خرج بالجسد. أولست أنت من أشار إليها أتون النار الممزوجة بالندى واللهيب، كصورة للنار والإلهية التي أتت وسكنت فيك؟
وخيمة إبراهيم كانت نذيراً عنك شديد الوضوح، لأن الإله الكلمة الذي أتى فسكن في حشاك كما تحت الخيمة، قد قدّمت له الطبيعة البشرية الخبز المشوي على الجمر، أي بواكيرها – من خلال دمك الفائق الطهر – المشوية والمحولة إلى خبز بواسطة النار الإلهية واللابثة في شخصها لتكون حقاً بمثابة غذاء لجسد أحيي بنفس عاقلة وناطقة.
وكنت سأُغفل سلم يعقوب. ماذا إذاً؟ أو ليس جلياً لكل (منا) أنها رسمت مسبقاً صورتك وأظهرتها؟ فكما رأى يعقوب السماء متحدة بالأرض من خلال أطراف السلم التي عليها تصعد ملائكة الله وتنزل، (ورأى) ذاك الذي هو بالحقيقة القوي الذي لا يُقهر مصارعاً إيّاه على سبيل الرمز، كذلك أنتِ، أصبحت الوسيطة والسلم التي بها نزل الله إلينا وحمل ضعف مادتنا بضمها إليه وباتحاده بها بدقة، وجعل من الإنسان ذهنا يرى الله، وبهذا قرّبت ما كان متباعداً. ولأجل ذلك نزلت الملائكة إليه لتخدمه كونه إلهها وسيدها، والبشر من جهتهم رُفعوا إلى السماء باعتناقهم حياة ملائكية.
9- وأي مقام أعطي لكلام الأنبياء الموحى به؟ أولاً ينبغي أن نعيده لك، إذا ما أردنا أن نُظهر صحته؟ ما هي إذا تلك الجزة التي تكلم عنها داود، والتي ابن ملك الكون وإلهه، الذي لا بدء له والسيد كأبيه، سينزل كالمطر عليها؟ أليست أنت بداهة؟
ومن هي العذراء التي في رؤيا نبوية، بشّر إشعيا بأنها ستحبل وتلد ابناً يكون “الله معنا”، الذي يعني بأنه صار إنساناً وهو لم يزل إلهأً؟
وما هو هذا الجبل الذي تحدث عنه دانيال والذي قُطع منه المسيح حجر الزاوية من دون تدخل أداة بشرية؟ أو ليست أنتِ، التي حبلت وهي بتول ولم تزل بتولاً على الدوام؟ وليتقدم حزقيال ويظهر الباب المغلق الذي اجتازه الرب من دون أن يُفتح، كما بشر به نبوياً، وليظهر إنجاز أقواله. إليك أنت كان يُشير بالتأكيد، يا من اجتاز فيها الإله ملك الكل وأخذ جسداً من دون أن يفتح باب البتولية. نعم، الختم البتولي ظل قائماً وسيبقى إلى الأبد.
وهكذا، الأنبياء يحتفلون بك، والملائكة خضعوا لك، والرسل في خدمتك والتلميذ البتول اللاهوتي يخدمك يا والدة الإله الدائمة البتولية. في اليوم الذي فيه قد ذهبت إلى ابنك، الملائكة ونفوس الصدّيقين والآباء والأنبياء كانوا يحتفّون بك بإكرام. وكان الرسل يشيعونك مع جمهرة عظيمة من الآباء الملهمين إلهياً. من أطراف الأرض جُمعوا بأمر الله وجُلبوا كعلى غمامة نحو أورشليم المقدسة والإلهية هذه، وإليك يا من كانت منشأ جسد الرب ومبدأ الحياة، راحوا يوجهون النشائد المقدسة في تسبيح إلهي بالكلية.
الرقاد – الانتقال إلى الحياة
10- أواه! كيف تقاد “ينبوع الحياة” إلى الحياة مروراً بالموت؟ با للدهشة! تلك التي تجاوزت في ولادتها حدود الطبيعة، تنحني الآن تحت نواميسها، وجسدها البريء من الدنس يخضع للموت! إذ يجب في الواقع أن يُنزع ما هو مائت لارتداء عدم الفساد، لأن سيد الطبيعة نفسه لم يرفض خبرة الموت. فقد مات بحسب الجسد وبموته حطّم الموت، وأضفى على الفساد عدم الفساد، وجعل من الموت ينبوع القيامة. أوّاه! هذه النفس القديسة في حين خروجها من المسكن الذي تقبّل الإله، كيف يتقبلها خالق العالم بيديه، وأي تكريم شرعي يحمله لها! بالطبيعة كانت خادمة، لكنه في لجج محبته للبشر التي لا تُسبر جعلها أمه الخاصة بترتيب التدبير (الإلهي)، لأنه تجسد بالحقيقة ولم يصبح إنساناً بالزور. وطغمات الملائكة كانت تراك بدون شك وتنظر انطلاقك من حياة البشر.
يا للإنتقال الذي لا مثيل له، والذي هو لك بمثابة نعمة الهجرة إلى الله! لأنه إذا وُهبت هذه النعمة من الله لجميع خدّامه الذين لديهم روحه – لأنها وُهبت لهم، والإيمان يعلّمنا ذلك – فالاختلاف مع ذلك يكون لا متناهياً فيما بين عبيد الله وأمه.
فكيف ندعو من ثم هذا السر الذي يتم فيك؟ موتاً؟ ولكن، إذا ما كانت نفسك الفائقة القداسة والطوبى قد انفصلت عن جسدك المبارك والبريء من العيب كما تريد الطبيعة، وإذا ما أُسلم هذا الجسد إلى القبر بحسب الناموس المشترك، فهو مع ذلك لن يقيم في الموت ولم يحلّه الفساد. فتلك التي بقيت بتوليتها سليمة في الولادة، حُفظ جسدها بدون انحلال عند انطلاقها من هذه الحياة، ووُضع في مسكن أفضل وأكثر تألهاً، في منجى من الموت، فيقدر على البقاء إلى الدهور التي لا نهاية لها.
شمسنا الساطعة بالكلية والمنيرة على الدوام، باحتجابها لوقت ما بجسم القمر، تبدو وكأنها اختفت مظللة بالظلمات وتحوّل لمعانها إلى ظلام. لكنها مع ذلك لم تتجرد من نورها الخاص بل هي تحوي في ذاتها ينبوع نور لا ينضب، أو بالأحرى هي نفسها ينبوع النور الذي لا يغيب، بحسب ترتيب الله الذي خلقها. هكذا أنتِ، ينبوع دائم للنور الحقيقي، كنز لا ينفذ لمن هو الحياة بالذات، تفتح البركة الخصيب، أنتِ التي هي لها علة كل الخيرات حتى ولو غاب جسدك في الموت بانفصال مؤقت تُنبعين لنا، مع ذلك وبسخاء، دفقات دائمة نقية لا تنضب، من النور غير المتناهي والحياة غير المائتة والبهجة الحقيقية، وأنهار النعم وينابيع الأشفية والبركة الدائمة. فلقد أزهرت “كالتفاحة بين أشجار الغابة” وثمرك حلو في حلق المؤمنين. ولن أقول بعد عن انصرافك المقدس إنه موت، بل رقاد أو عبور، أو دخول في مسكن الله أكثر دقة. فبخروجك من حيز الجسد، تدخلين في حالة أفضل.
11- الملائكة مع رؤساء الملائكة يحملونك معاً، وبخروجك ارتعدت الأرواح النجسة الجائلة في الفضاء. بعبورك بورك الجو وتقدس الأثير. السماء تتقبل نفسك بفرح، والسلاطين تتقدم للقائك منشدة التسابيح باحتفال ملأه الحبور، وهي تقول هذا من دون شك: “من هذه الطالعة بكل بهائها”، “المشرق كالصبح، الجميلة كالقمر، البهية كالشمس؟ ما أجملك وما أعذبك! أنت يا “نرجسة السهول” التي “كالسوسنة بين الشوك”. “لذلك أحبتك العذارى”، و”إلى عبير أطيابك” نجري، (إلى حيث) “يدخلك الملك، إلى خدره وعندها تحتف بك السلاطين، وتباركك الرئاسات، والعروش ينشدون لك، والشيروبيم يجذلون منذهلين، والسيرافيم يمجّدون من هي حقاً أم سيدهم الخاص بالطبيعة بحسب التدبير. لا، لستِ كإيليا فحسب، ترتقين “نحو السماء”، ولم تُخطفي مثل بولس “إلى السماء الثالثة”، لكنك تقدمتِ نحو العرش الملكي الذي لابنك نفسه، بالنظر المباشر والفرح وبثقة عظيمة لا ينطق بها، ووقفت بالقرب منه: بهجة لا توصف للملائكة، ومعهم لجميع القوات التي تسود العالم، للآباء لذة لا حدّ لها، وللصدّيقين فرحاً لا يفسر، وللأنبياء ابتهاجاً دائماً، تباركين العالم وتقدّسين الكون بأسره. تكونين الراحة في التعب، “والتعزية في الأحزان”، الشفاء في الأمراض والميناء في العاصفة، الغفران للخطأة والتشجيع العطوف للمبتلين، والعون السريع لجميع الذين يدعونك.
انقلاب الموت إلى فرح
12- يا للعجب الذي يفوق الطبيعة حقاً! وقائع مذهلة! الموت الممقوت والمشجوب قبلاً، قد أحاطت به المدائح واعتُبر سعيداً: فيعد أن كان يجلب الحداد والحزن، الدموع وألمّ الكئيب، ها قد ظهر علة فرح ومحط عيد احتفالي. وعلاوة على ذلك بالنسبة إلى جميع خدّام الله الذين أُعلن موتهم سروراً، وحدها خاتمة حياتهم تعطيهم اليقين بأنهم قُبلوا من الله، ولهذا طوّب موتهم. لأنه يختم كمالهم ويُظهر غبطتهم، حيث يضفي عليهم رسوخ الفضيلة بحسب إعلام الوحي: “لا تعتبر أحدأً سعيداً قبل موته”. لكننا لا نطبق عليكِ هذا القول، لأن غبطتك لا تأتي من الموت وموتك لم يُتم كمالك. كلا، ليس انطلاقك من هاهنا أسفل هو الذي ثبتك في النعمة. فلأجلك كل الامتيازات السامية وانتصافها ونهايتها، توطدها وثباتها الحقيقي، فكانت الحبل البتولي والسكنى الإلهية والولادة من دون أذية. وقد قلتها أيضاً بالحقيقة، أن ليس عند موتك، بل منذ هذا الحبل عينه تُدعين مغبطة من جميع الأجيال. لا، ليس الموت أبداً من جعلك، مغبطة، بل أنتِ التي ألقت الموت، وبدّدت كآبته وأظهرت أنه فرح.
ولهذا أُسلم جسدك المقدس الذي لا عيب فيه إلى القبر. الملائكة تقدّموه وأحاطوا به وتبعوه، وما الذي لا يفعلونه لخدمة أم ربهم كما يليق؟ الرسل والكنيسة في ملئها ينشدون الترانيم الإلهية كآلات ينفخ فيها الروح (القدس)، وقائلين: “سنشبع من خيرات بيتك، وشعبك مقدس عجيب في العدل”. وأيضاً: “لقد قدّس العلي مسكنه”، “جبل الله، جبل خصيب، الجبل الذي ارتضى الله أن يسكنه!”.
الرسل معاً يحملونك على أكتافهم، أنت التابوت الحقيقي، كما حمل الكهنة قديماً التابوت الرمزي، ووضعوك في القبر: ومنه عندئذ، كما من أردن آخر، أوصلوك إلى أرض الميعاد الحقيقية. أعني “أورشليم العلوية”، أم جميع المؤمنين، التي “ألله مهندسها وبانيها”. لأن نفسك لم تنزل “إلى الجحيم” بالتأكيد، بل أكثر من ذلك، جسدك نفسه “لم يرى الفساد”. لم يُترك جسدك البريء من الدنس والفائق الظهر للأرض: بل حُملت إلى المساكن الملكية في السماوات، أنت الملكة والسيدة والمعلمة، أم الله ووالدة الإله الحقيقية.
13- ماذا (أقول)؟ السماء استقبلت من ظهرت أسمى من السماوات، والقبر تقبل من جهته من كانت إناء الله! أجل، لقد تقبّلها، أجل، لقد حواها. إذ ليست الضخامة الجسدية من جعلتها أوسع من السماء: فكيف لهذا الجسد ذي الأذرع الثلاثة، والذي يتقلص بدون انقطاع، أن يُقاس بعرض السماء وطولها؟ ولكن لا، فلقد تجاوزت بحسب النعمة قياس كل علو وكل عمق، لأن ما هو إلهي ليس له البتة ما يُقارن به. أيتها الصرح المقدس، الجدير بالإعجاب والشرف والإكرام! الآن أيضاً يصطف الملائكة حولك ها هنا وقد ملأتهم (مشاعر) الاحترام والمهابة، والشياطين ترتعد، والبشر يدنون بإيمان موقرين لك ومكرمين، فيحيونك ينظراتهم وشفاههم وميول نفوسهم، ويأتون ليغترفوا فيضاً من الخيرات.
أن يوضع عطر ثمين على ثياب أو في مكان ما ثم ينزع منها: فبقايا عرفه تبقى أيضاً، حتى ولو اختفى العطر! هكذا هذا الجسد الإلهي والمقدس والبريء من الدنس، والمشبع بالعرف الإلهي، منهل النعمة الفيّاض، بوضعه في القبر ثم استعادته محمولاً إلى مكان أكثر امتيازاً وسمواً، لم يدع القبر بدون شرف، لكنه حمل إليه طيبه الإلهي ونعمه، وجعل من هذا الصرح ينبوع الأشفية وكل الخيرات لجميع الذين يدنون منه بإيمان.
14- ونحن أيضاً نقف اليوم في حضرتك أيتها السيدة، نعم أقولها ثانية، أيتها السيدة البتول والدة الإله: نعلّق نفوسنا بالرجاء الذي هو أنت بالنسبة إلينا، كأن بمرساة راسخة لا تنكسر، ونكرّس لك روحنا ونفسنا وجسدنا، كل منا بكلّيته. نريد أن نكرّمك “بمزامير وتسابيح وأناشيد روحية”، بقدر ما لدينا: لأن مدحك بحسب كرامتك يتعدّى قوانا. وإذا صح، بحسب الكلام المقدس، أن الإكرام المؤدّى لسائر الخدّام هو دليل حب تجاه السيد المشترك، فكيف يمكن إهمال الإكرام الذي لك يا أم ربها! أولاً ينبغي التفتيش عنه بحماس؟ أو ليس مفضلا على النسمة الحيوية عينها، وألا يعطي الحياة؟ فهكذا نشير بشكل أفضل إلى تعلّقنا بمعلّمنا الخاص. وماذا أقول؟ يكفي في الواقع لهؤلاء الذين يحفظون ذكراك بتقوى أن يُمنحوا هبة تذكرك المتعذر تقديره، فيصبح أوج الفرح الخالد. وبأية بهجة لا يمتلئ، وبأية خيرات، ذاك الذي جعل من فكره المقام الخفي لتذكرك الجزيل القداسة؟
ها هي شهادة عرفاننا بالجميل، وبواكير خُطبنا، ومحاولة فكرنا البائس الذي وقد أنعشه حبك، نسي ضعفه الخاص. ولكن، تقبّلي بعناية رغبتنا المضطرمة عالمة أنها تتجاوز قدراتنا. وانظري إلينا أيتها السيدة السامية وأم سيدنا الصالح، ودبّري وقودي مصيرنا كما تشائين، هدّئي تحركت أهوائنا المخزية، وأرشدي سبيلنا إلى ميناء المشيئة الإلهية الذي لا عواطف فيه، وأنعمي علينا بالبهجة الآتية، هذه الاستنارة العذبة بوجه كلمة الله نفسه، الذي تجسد بواسطتك. لأبيه وله المجد والكرامة والقدرة والجلال والعظمة، ولروحه الكلي قدسه، الصالح والمحيي، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.